-
قضايا مؤجلة للنهضة العربية الحديثة
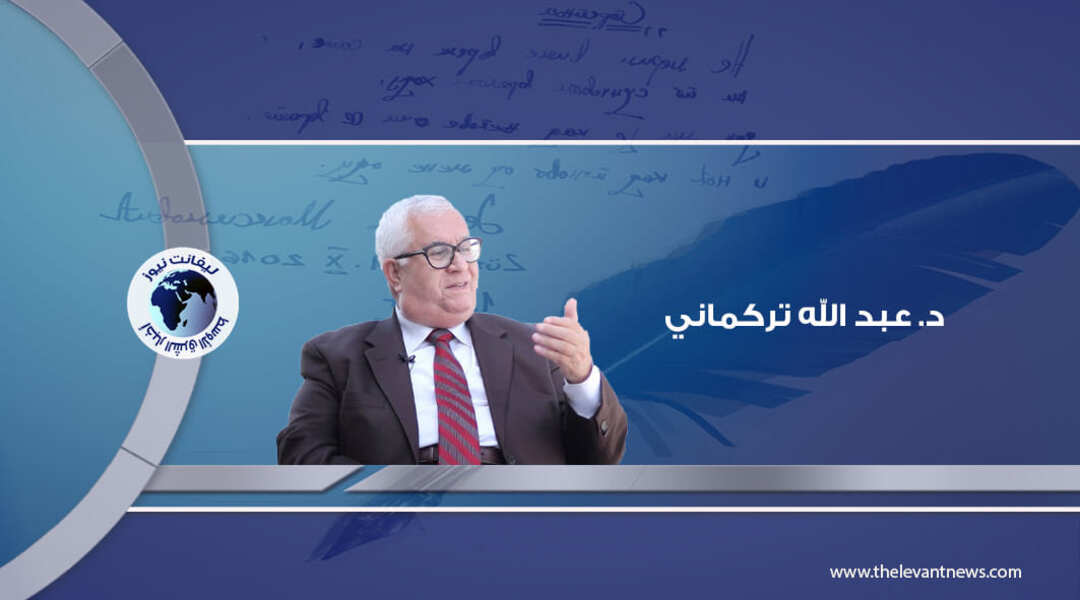
يبدو أنّ قضية الحرية هي إحدى أهم هذه القضايا المؤجلة، فالعرب اليوم هم الأقل تمتعاً بالحرية بين شعوب العالم، إذ لم تنشأ في العالم العربي دولة الحق والقانون التي من شأنها أن تشكل ضمانة لحقوق الإنسان وحريته، ولم تراعَ إرادة المواطنين في تنصيب الأنظمة السياسية، فكان العقد الاجتماعي اعتباطياً ومفتقراً إلى الشرعية الدستورية، حتى أنّ أغلب دول العالم العربي اعتُبرت استثناء في عصر الديمقراطية الراهنة.
ولا تقل قضية التنمية إرباكاً وإحراجاً، إذ بعد زهاء قرنين على تجربة محمد علي النهضوية، لا يزال العالم العربي، على رغم مساحته الشاسعة وثرواته الكبرى وكفاءاته المهاجرة، يعاني أزمات حادة.
وفي موازاة قضية التنمية تبرز قضية مجتمع المعرفة، إذ وفق تقرير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الأليكسو " وصل عدد الأميين العرب إلى 70 مليوناً. أما إسهام العرب في الابتكارات العلمية والثقافية فيقرب من الصفر، في حين أنّ إسرائيل حافظت، منذ عام 1967 إلى اليوم، على تفوقها الكبير على مجموع العالم العربي في الأبحاث العلمية، على رغم وجود أكثر من 175 جامعة عربية، وأكثر من ألف مركز للبحث والتطوير.
إنّ الأكثر إثارة للدهشة هو تلك النوعية المنخفضة من التعليم الذي يخلق نوعيات من البشر جاهزة كـ " القطعان " للقيادات الديماغوجية والشعبوية تقودها إلى حيث تريد، وكل ذلك تولد عن نظرة إلى التعليم والمعرفة بوجه عام لا تضعه ضمن أولويات الدولة العربية التي تغلبت عليها أولويات أخرى.
هذه الكارثة، سواء فيما تعلق بالأمية أو بنوعية التعليم أو وضع المعرفة والبحث العلمي، تم التركيز عليها خلال الأعوام الأخيرة ولكنّ كافة الأفكار التي تناولتها وعملت على تجاوزها واجهتها مقاومة عنيفة تتسلح مرة بـ " الخصوصية الثقافية "، ومرة أخرى بـ " مقاومة الغزو الثقافي الأجنبي "، وفي كل الأوقات تُشْهَرُ " الهوية " سلاحاً لإبقاء الأوضاع التعليمية على ما هي عليه.
وضمن هذا السياق، ينبغي إعطاء الأولوية الكبرى لقطاع التعليم والثقافة لعلاقتهما الجدلية والوطيدة مع التنمية بكل مظاهرها، وذلك من خلال رصد اعتمادات مادية وتقنية مهمة في هذا السياق، أسوة بالعديد من البلدان الرائدة والنموذجية في هذا المجال (إنفاق العرب على البحث العلمي لا يتجاوز 0.2 % من مجموع الناتج القومي، مقابل 3 % في إسرائيل..).
إنّ إقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية تنتظم حول أركان خمسة: إطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم وضمانها بالحكم الصالح، والنشر الكامل للتعليم الراقي النوعية مع إيلاء عناية خاصة لطرفي المتصل التعليمي وللتعلم المستمر مدى الحياة، وتوطين العلم وبناء قدرة ذاتية في البحث والتطوير التقني في جميع النشاطات المجتمعية، والتحول الحثيث نحو نمط إنتاج المعرفة في البنية الاجتماعية والاقتصادية العربية، وتأسيس أنموذج معرفي عربي عام وأصيل ومنفتح ومستنير.
وفي ما يتعلق بالتعليم، فإذا أردنا – في أواسط القرن الحالي - أن يكون لدينا جيل قادر على التفاعل مع متطلبات التنمية فينبغي أن نبدأ، منذ الآن، بإصلاح جدي فعلي لمناهج تعليمنا. فكما أننا بحاجة إلى فكر عربي تنموي عام فإننا أكثر حاجة إلى وضع برامج تعليمية تنموية قادرة على أن تخلق، لدى أجيالنا العربية الجديدة، العقلية التحليلية والنقدية الجيدة والمعرفة التقنية المناسبة. فربما يكون تطوير التعليم هو المعركة الأهم التي يجب أن نخوضها على الفور، فهذه معركة حتمية وعاجلة ويتوقف عليها مستقبل أجيال قادمة، للتعاطي المجدي مع التحدي الحضاري الذي نعيشه، والخروج من الهزائم والانتكاسات التي لعب التأخر العلمي والتكنولوجي، بالطبع إضافة إلى ديمومة الاستبداد، دوراً بارزاً فيها.
أما قضية حقوق المرأة، الإنسانية والسياسية والاجتماعية، فقد دلت التقارير المتعددة لمراكز البحوث والدراسات على أنه لا يزال يسود معظم الدول العربية اتجاه تقليدي ينزع إلى حرمان المرأة من حقوقها المدنية والعامة والأسرية، إذ لم تكتسب بعد حقوقها المهنية، ولا يزال نشاطها الاقتصادي الأدنى في العالم. وتشير تقارير دولية وإقليمية وعربية إلى تعرّض نسبة عالية من النساء العربيات للضرب والإيذاء الجسدي، وإلى حرمانهن من حقوقهن في اختيار الزوج، وفي المشاركة في الحياة السياسية.
ومن أخطر القضايا التي مازالت مشرعة قضية المواطنة والاندماج الوطني، فبعد مرور ما يزيد عن القرن على مناداة النهضويين العرب بحقوق المواطنة، يظهر العالم العربي على حال من التفتت والتشرذم القبلي والطائفي والمذهبي والعشائري، وكأنه عصيٌّ على الاندماج الوطني، مهددٌ على الدوام بالحرب الأهلية والنزاعات ما قبل الوطنية.
لقد أخفقت نظم الحكم السلطوية في إنجاز عقد اجتماعي طوعي بينها وبين المواطنين، يحمي حقوق الإنسان، ويضمن قدراً معقولاً من شروط العيش الكريم. في حين أنّ الفضيلة السياسية تتجلى، كما ذكر الباحث جاد الكريم الجباعي، في المواطنة التي قوامها الحرية والمساواة والمشاركة والمسؤولية وابتغاء الخير العام. والمواطنة بهذا المعنى وثيقة الصلة بالحداثة وبالدولة الحديثة، بل هي من أهم المبادئ التي تقوم عليها هذه الدولة التي يستمد منها الوطن جميع دلالاته السيادية والسياسية والحقوقية والأخلاقية.
لقد كفَّ الوطن عن كونه مجرد رقعة جغرافية، أو بيئة طبيعية، أو حتى مجرد حدود سياسية معترف بها، بل غدا علاقة إيجابية مثلثة الأطراف: علاقة بين الإنسان والطبيعة (العمل)، وعلاقة بين الإنسان والإنسان (التعامل)، وبين الإنسان والدولة (المشاركة السياسية)، وهي علاقة ذات محتوى اجتماعي اقتصادي وثقافي وسياسي وقانوني وأخلاقي، يمكن إجمالها بكلمة واحدة هي المواطنة، بما تنطوي عليه من عضوية الفرد الفعلية في الدولة السياسية ومشاركته الإيجابية في الحياة العامة. ومن ثم فإنّ مفهوم الوطن لا يقوم من دون مفهوم المواطن، من دون مفهوم المواطنية والمواطنة.
وهكذا، لن نبالغ إن قلنا إننا دخلنا بالفعل عصراً جديداً من الصراعات والحروب الأهلية، المبنية على أسس طائفية وخلافات دينية وثقافية وتفاوتات اجتماعية، بعد أن عجزت الحروب والحملات العسكرية والغزوات الاستعمارية عن تحقيق أهدافها.
ليفانت-عبدالله تركماني
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!























