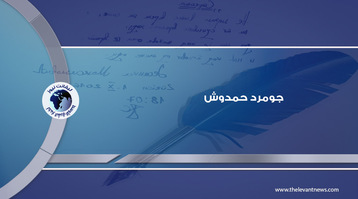-
مراحل تصدّع وانهيار الثقة بين المجتمعات السورية

منذ الانقلاب العسكري لحافظ الأسد قبل نصف قرن بدأت الثقة تتزعزع بين النظام، الذي عمل على توليف وإخراج بُنية الدولة السورية على قاعدة الهرم الدكتاتوري، والتي عكستها صورة الخطاب السياسي الخادع والشعاراتي الصاخب للحزب القائد للدولة والمجتمع، التي رافقت مسيرة تأليه الفرد وتعميم الاستبداد ونشر الخوف والفقر، وفق الشكل الذي آل إليه الوضع إلى توريث الابن البديل عن الوريث الأصل، الابن البكر، الذي غيَّبه الموت المفاجئ إثر حادث مروري لم يزل يحمل إشارات استفهام حول حِدّية مبدأ الصراع على السلطة في الشرق الأوسط وبلاد الشام في حاضرتها الأموية، دمشق الفيحاء.
الاصطفاف المذهبي
بدأ جدار الثقة بالتصدّع مذهبياً، حيث برزت الطائفية عارية، عند مجابهة الأغلبية السنيّة بطريقتين مختلفين، أولهما: ضمان ولاء العسكريين منهم وإشراكهم في أعمال الحكومة من خلال تسخيرهم وربط مصالحهم الشخصية بالوظائف (وزارة الدفاع ـ رئاسة الأركان ـ وزارة الخارجية) وحكرها على هؤلاء لمدى الحياة، ومنح المدنيين صفات حزبية في القيادة القطرية والقومية لحزب البعث الذي كان يقود الدولة والمجتمع لصالح سلطة النظام الاستبدادية الحقيقية وجوهر الحكم الطائفي الوراثي.
ثانيهما: مواجهة النخب والتيارات المتعلّمة والمثقفة في المجتمع المديني وحل النقابات المهنية الحرة والمنتخبة، حيث تمحور الهدف، النيّل من حالة التَديّن التقليدية العامة بين الناس، ومن جانب آخر عزل حركة الإخوان المسلمين وقطع صلة حراكهم الدعوي، سواء في بيئاتهم التقليدية أو حراكهم المجتمعي العام ودفعهم للعمل السري، وبالتالي مواجهتهم بالقتل والتدمير وتجريم الانتساب إليهم قانوناً، في اعتقاد خاطئ من النظام بأنّ عام 1982 سيكون نهاية وجود الجماعة الفعلي على الأرض، وهو مدرك بأنّ التنظيم هو تنظيم عالمي، ينشط في معظم دول الإقليم المجاور، ويلقى الدعم لأسباب مختلفة، يتعلّق بصراع الأنظمة في المنطقة، وهكذا اصطفّ الشعب السوري مذهبياً، أمام واقع انهيار تام للثقة المستندة على دعائم الوطنية، من خلال إنهاء الحياة السياسية في البلد وفق ما كان سائدا من قَبل، خلال الانتداب الفرنسي وعقب خروجه والبدء باستدعاء عناصر التاريخ التناحري الدموي منذ أكثر من ألف و أربعمائة عام من الصراع على الولاءات، فالطائفيّة من أكثر الأسباب التي أدّت إلى ترسيخ الشرخ المجتمعي في سوريا.
لهذا فإنَّ التدخل الإيراني في دعم النظام ومواجهة الثورة السلمية عام 2011، جاء مبكراً وعنيفاً، في مسعى من حكم ولاية الفقيه على ديمومة الحكم في سوريا في حالته الطائفية منذ أنْ تأسست العلاقة بينهما، عند انتقال الخميني من باريس إلى طهران لاستلام الحكم، وتحدّدت ملامح العلاقة بالقطيعة مع عراق صدام حسين والانحياز التام لإيران، عند اندلاع الحرب بين البلدين في أيلول عام 1980، وتطورت حلقات الرابطة المذهبية وأصبحت أكثر صلابة من خلال حشد إيران للميليشيات الشيعية من مختلف حواضنها البائسة وزجَّها في الحرب في مواجهة الشعب السوري، وخاصة في الدول التي شهدت حروباً أهلية، كالعراق وأفغانستان ولبنان، وكان لتدخل حزب الله المؤشر الذي لا يقبل الشك، بأنّ أذرع إيران قد تغوّلت على الدول والحكومات التي أصبحت رهينة سياسات إيران في الشرق الأوسط، أعقبه في المقابل، توجّه أفراد وجماعات من مختلف دول العالم، بهدف نصرة أهل السنة والجماعة، فيما كانت تسمى بـ(جبهة النصرة)، جرى الأمر كله بتسهيل من معظم دول الإقليم، وخاصة تركيا، حيث كان حصيلة الصراع التآمري، ظهور تنظيم (داعش) الإرهابي بهذه القوة والتمدّد، حتى شملت سطوته مساحات واسعة في كل من سوريا والعراق، وتركّزت في حواضر أهل السنة من الموصل إلى الرقة، بهذا نجحت الجمهورية الإسلامية مرة أخرى في تحييد النظام الأسدي من الاستهداف ومنعه من السقوط، بدعوى مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
ضمان ولاء الأقليات الدينية والمذهبية لتلميع صورة الحكم الدكتاتوري
المسيحيون بكافة طوائفهم أصبحوا جزءاً من النظام الشمولي، سواء من خلال ضمان ولاء رجال الكنيسة أو تسلّم مناصب في حزب البعث أو تخصيصهم بوزارات ووظائف حكوميّة، وكذلك تماهت الطائفة الإسماعيلية مع العلوية من حيث الشكل وتقلُّد المناصب والامتيازات، في حين ضمنت الطائفة الدرزية امتيازات مخصوصة بها في الحزب والجيش والحكومة، واشتركت معظم الطوائف من خلال قائمة جبهة البعث التقدّمية وهوامش قوائمها السوداء لضمان مقاعد في مجلس الشعب الصوري، لإضفاء التعدديّة الشكليّة على المؤسسات الرديفة لنظام الاستبداد والطغيان، بالرغم من تقاطع المصالح الشخصية الفردية والفئوية مع الطائفة الحاكمة، إلا أنَّ الشعور الطائفي وفق خصوصية كل مذهب وطائفة وتقوقعها التاريخي أصبح هو السائد، ولم تؤسس لمجتمع متجانس قائم على الثقة المنبثقة عن الانتماء الوطني الجامع.
بقيت هذه الطوائف خلال الثورة السورية محايدة، منعزلة في جزرها، يكتنفها التقلّب بين ولاء سلبي مع النظام أو المشاركة إلى جانب النظام من خلال تجنيد أبنائها، حيث بقيت سويداء في منأى من جارتها درعا، وهما يشكلان جبل وسهل حوران، فيما بقيت بعض حارات دمشق، التي يغلب عليها الطابع المسيحي، بمعزل عن حارات خاصرة دمشق وريفها، بينما تخلّفت السلمية عن نصرة حمص وريفها، والحال ينطبق على حلب، حيث أودع النظام بعض حاراتها برسم الأمانة والوكالة لدى سلطة حزب الاتحاد الديمقراطي.
تنامي الشعور بالمناطقية وفق التقسيمات الإدارية
أصبحت المناطقية أساساً للشعور باللانتماء الوطني، على الرغم من طول أمد الحكم المركزي الشديد الذي كرّسه الحكم الاستبدادي الشمولي، لنظام قائم على الاستعباد والاسترقاق، فالانتماء المناطقي أصبح أكثر دلالة على المكان عندما انسحب جيش النظام إلى مناطق سوريا المفيدة وترك خلفه مساحات واسعة تشمل محافظات كاملة وخاصة شرق الفرات، لعزل مناطق التواجد الكوردي عن الثورة في البداية عام 2012، وكذلك لترتيب تمدّد تنظيم (داعش)عام 2014، في محافظتي دير الزور والرقة، بمحاذاة الحدود العراقية في محافظتي الموصل والأنبار تنفيذاً لسياسات المحور الشيعي الذي تقوده إيران، إلا أنَّ الجهد الدولي المتمثّل بالتحالف الغربي الأمريكي، تمكّن من إدارة الصراع بعد التخلّص من (داعش) في مناطق نفوذه، بجعل حزب الاتحاد الديمقراطي وقوّات سوريا الديمقراطية في حلٍّ من التكاليف التي قد فرضتها الاتفاقات السابقة مع النظام وراعيته إيران، فيما يشمل كوردستان سوريا ومناطق شرق الفرات، وفي المقابل فرضت المناطقيّة نفسها على تحركات الجيش الحر، بحيث أصبح كل فصيل يعمل ضمن جغرافية محددة، وكانت الدول الداعمة له تحدّد تلك التكتيكات، ولم تؤسس لاستراتيجية شاملة متكاملة حتّى يتم إسقاط النظام لأسباب كثيرة تتعلّق بالمصالح الدولية وأمن إسرائيل، وكذلك الصراع المذهبي المستتر الذي يمثّله كل من تركيا وإيران، رغم توافقهما على منع قضية الشعب الكوردي في سوريا من التطور باتجاه الحل، كما جاء التدخل الروسي في المعارك لصالح النظام عام 2015 إلى بروز وتقاطع مصالح الدول الإقليمية إلى السطح، من خلال ما تسمى بالمصالحات والمقايضات، وبالنتيجة أصبحت مناطق النفوذ تأخذ ملامحها الجيوسياسية، وخاصة بعد تميكن تركيا بتواطئ روسي وتغريدات مشبوهة على (تويتر) من الرئيس الأمريكي (ترامب) بالانسحاب، وبالتالي احتلال مناطق غرب كوردستان (عفرين/ كورد باغ، كرى سبي/ تل أبيض، سرى كانيه/ رأس العين)، ومن الجدير ذكره اختفاء الجيش الحر من الساحة بعد التآمر الإقليمي والدولي، وتخلّي ما كان يسمى بأصدقاء للشعب السوري عنه، حيث استعاض بـ(الجيش الوطني) العائد للائتلاف السوري التابع لتركيا، الذي أصبح يعمل في الارتزاق والإذلال داخل سوريا وخارجها.
فقدان الثقة بين المكونات القوميّة
كرَّس النظام الأسدي مفاهيم عنصرية تمجِّد القومية العربية السائدة، ابتداءً وانتهاءً من منطلقات منصّته الشكلية الخادعة بقوالبها السياسية والفكرية والشعاراتية لـ(بعث الأمة)، كحزب يقود الدولة والمجتمع، واستخدمه لحشد القطيع الشعبي الغوغائي لتنفيذ سياساته الشوفينية بمواجهة الشعب الكوردي في سوريا، لهذا لم يؤسّس أصلاً لثقة من المفترض أن تكون موجودة على أسس وطنية، لمكون قومي مختلف، له خصوصيته الثقافية، حيث استمرّ تعامله الأمني مع الشعب الكوردي طوال فترة حكمه الإجرامي، من خلال ضرب التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، لهذا تآمر منذ بداية الثورة، من خلال الانسحاب من مناطق التواجد الكوردي وتسليمه لسلطة حزب الاتحاد الديمقراطي، في مسعى منه لمنع أي تطور يتعلّق بحقوق الشعب الكوردي القومية العادلة على أسس وطنية سورية، إلا أنّ تصاعد الأزمة السورية بالتدخلات الدولية وطول أمدها حال دون تنفيذ سياساته بالشكل المرسومة لها، وفي ذات الحين، تقاطعت تلك السياسات مع الرؤية السلبية للمعارضة السورية السياسية لحل القضية الكوردية، فيما ساهمت فصائلها العسكرية التابعة لتركيا في انهيار الثقة وتوسيع الفجوة من خلال القيام بالتقدّم، أما الجيش التركي، كأدلاء ومأجورين، لاحتلال مناطق تواجد المكون الكوردي والقيام بأعمال إجرامية وتغيير ديموغرافي، لا يقلّ عن إجرام النظام.
رؤية الموفد الأممي لإعادة الثقة
لا أعلم إن كان السيد غير بيدرسون بحكم تجربته، وسلفه السيد ديمستورا، يدرك جيداً مدى عمق وسعة الهُوَّة التي تُشكّلها عدم الثقة بين طرفي اللجنة الدستورية السورية، التي اجتمعت للمرة الرابعة في جنيف، وهو متيقن تماماً بأنّ طرفي النقيضين لا يمكنهما ردم الفجوات العميقة على كامل الجغرافيا السورية، الطبيعية والبشرية، بهذه السهولة، ربما هي اختلاف الثقافة بين رؤية الموفد الأممي وموقف المتفاوضين، وكذلك مدى استعداد الطرفين المتفاوضين لتقبّل المفاهيم الجديدة التي تطفو على سطح المستنقع السوري، بعد مرور عقد من الزمن على الاحتراب الداخلي والتدخلات الخارجية، بالرغم من استمرار النظام المجرم وداعميه بإخفاء الفظائع، كأنَّ شيئاً لم يكن، وتغطيته الأمر بانتصاره المزعوم على الإرهاب.
الفجوة العميقة للثقة التي أحدثها الزلزال السوري لا يمكن ردمه، بمخلفات الهدم التي طالت بيوت السوريين الآمنين فوق رؤوسهم، ولا يمكن لمشروع عالمي، كمشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية، لإعادة الأعمار وتسوية الفجوة بالأرض دون بروز تضاريس المقابر الجماعية وضحايا التعذيب في السجون والمعتقلات وأرواح المدنيين الآمنين الذين فقدوا حياتهم بفعل قصف الطيران والبراميل المتفجرة والسلاح الكيماوي، عدا ما دُفن في التراب في مختلف المناطق، من الشهداء والقتلى، من معظم الأطراف التي شاركت الحرب في سوريا، فاستمرار المآسي هذه باعدت بين الطرفين، ليس نفسياً، وفي البعد الروحي للإنسان فحسب ، بل فصلتهم بسواتر الحقد والكراهية بمقدار تعدد مناطق النفوذ التي يتحكم بها المتدخلون من القوى الدولية والإقليمية لصالح هذا الطرف أو ذاك، دون أن تجبر قلوب السوريين، بمختلف انتماءاتهم، في وطن لا بدَّ أنْ يمرّ بفترة انتقاليّة، وفقاً للقرارات الأممية، يمهد لإعادة بنائه من جديد على أسس من العدل والإنصاف والحياة الكريمة.
ليفانت - قهرمان مرعان آغا
العلامات
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!