-
تقهقر التصنيع وتصاعد صناعة الخدمات في العالم المتقدم
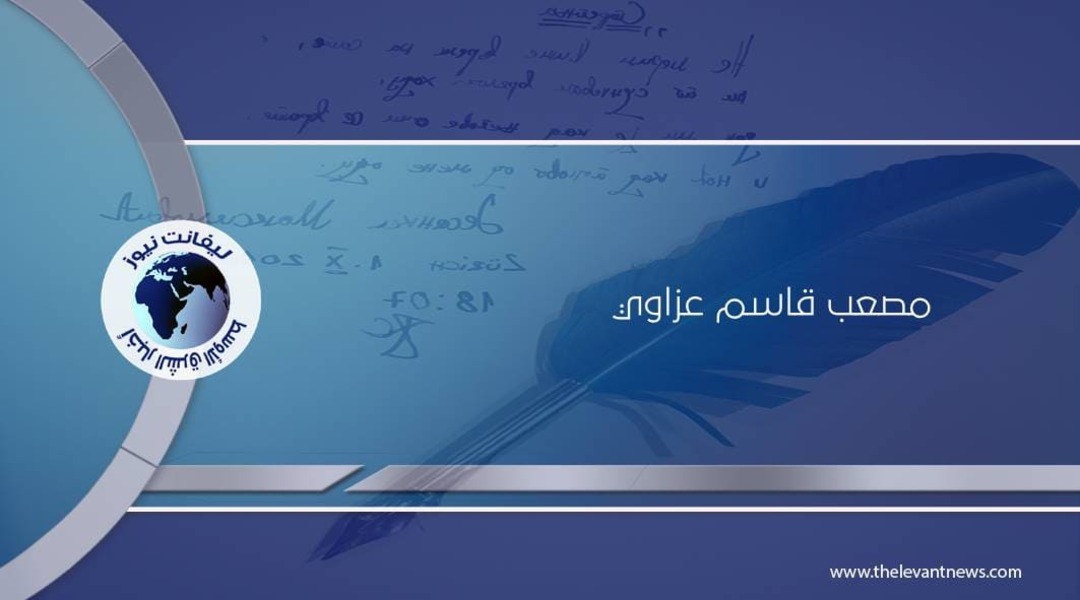
لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف الجوهري والأسمى للرأسمالية عموماً، وخاصة شكلها الوحشي المعولم المتسيد كونياً راهناً، يتمثل في الوصول إلى أعلى مستوى من الربحية على المدى القصير، وأسهل طريقة للوصول إلى ذلك يتمثل في تصدير العمليات الإنتاجية إلى دول قمعية محظور فيها تنظيم العمال نقابياً، وأياً ما قد ينتج عن ذلك من إضرابات عمالية لتحسين الأجور، وذلك بقوة الاستبداد، بغض النظر عن تلاوينه التي قد يتخذها، سواء مقنعاً بلبوس شيوعي خلبي، كما هو الحال في الصين مثلاً، أو طغياناً شمولياً لا قناعاً على وجهه القبيح، كما في حالة الكثير من الطغم الحاكمة في دول العالم النامي، كما في مثالها النموذجي في العديد من دول أمريكا الوسطى والفليبين.
وهو الواقع الذي يتساير دائماً في تلك الدول القمعية مع إهمال كلي لأي قوانين تعنى بحماية البيئة من التلوث، وحماية العمال من الآثار الجانبية والأخطار المهنية المتعلقة بطبيعة عملهم التي قد يكتنفها الكثير من المخاطر الصحية عدا عن تلك المهنية، وهو ما يترافق غالباً مع حالة من الضعف الاقتصادي البنيوي والفساد الإداري الشامل عمقاً وسطحاً، والموغل دائماً بالتبجح بأرقام ما استجلبه من استثمارات خارجية على الرغم من أن حصة الأسد من عوائدها تذهب إلى مستثمرين أجانب يقومون بتهريب أرباحهم إلى الخارج، ولا يقومون بدفع أي ضرائب عن أرباحهم عملياً في الدول النامية التي يستثمرون فيها، سواء بسبب حصولهم على تسهيلات ضريبية، أو بسبب تهربهم الضريبي المستدام والذي لا رقيب ولا حسيب عليه بقوة قوانين الفساد والإفساد الضمني أو المعلن في نظم الاستبداد والطغيان.
وذلك الواقع بكليته لا بد أن يكون ناتجه الموضوعي الأكثر وضوحاً مشخصاً في زيادة مهولة للأرباح على حساب العمال الذين لا بد لهم من العمل بأجور زهيدة بالكاد تبقيهم على قيد الحياة، وهو الواقع البائس الذي أفصح عن نفسه بتعملق مالي مهول للشركات الكبرى العابرة للقارات، وانتقال جل الصناعات التي تستدعي قوة عمل كبيرة من الناحية العددية من الغرب إلى دول العالم النامي لاستدامة ذلك الإثراء المنفلت من كل عقال على حساب العمال المقهورين في دول العالم النامي، والإبقاء على الصناعات الخدمية، وتلك التصنيعية القائمة على نهج صناعات اللمسة الأخيرة في حياض دول الشمال الغني، وهو ما يمنح الرأسمالية الاحتكارية الوحشية المعولمة ميزة تفاضلية أخرى في قلب العالم الغربي نفسه، تنطلق أساساً من أن الغالبية المطلقة من تلك الصناعات التي تم ترحيلها إلى دول العالم النامي تتطلب قوة عمل مؤهلة تأهيلاً عالياً وهائلة من الناحية العددية يمكن لها المطالبة بحقوق عمالية موسعة في حال تواجدها في جغرافيا العالم الغربي بالاتكاء على قوانين العمل التي تقدم حماية جزئية للعمال في الغرب، والتي هي موروثة من حقبة الحرب الباردة حينما كانت النظم السياسية في الغرب مجبرة على تبني نهج دولة الرفاه لضمان عدم تفكر شعوبها باختيار نموذج مشابه لذاك القائم آنذاك في الاتحاد السوفيتي بقوة صناديق الاقتراع في الغرب نفسه.
وهو ما يمكن تلافيه والالتفاف عليه كلياً في سياق ترحيل جل العمليات التصنيعية سوى تلك المتعلقة بصناعات اللمسة الأخيرة من العالم الثري المتقدم إلى فضاء العالم النامي، وذلك بتمكين المشغلين في الغرب من استبدال أي عمال يرغبون في الاتكاء على القدرات النظرية للديمقراطية الشكلية في تلك النظم، كما هو الحال في محاولة الإضراب لتحسين الأجور، أو السعي للانتظام في اتحادات نقابية مستقلة وفاعلة تدافع عن حقوق العمال المالية والمهنية والصحية وغيرها، إذ إن الغالبية المطلقة من عمال صناعات الخدمات وصناعات اللمسة الأخيرة لا يحتاجون إلى تأهيل رفيع، كما هو الحال في الصناعات الإنتاجية، وخاصة تلك الدقيقة منها، وهو ما يرفع الكوابح عن أي سلوك ارتكاسي قد يقوم به أي مُشَغَّلٍ حين يتخذ قراراً بإنهاء العلاقة التعاقدية مع أولئك العمال المضربين أو المنتظمين في اتحادات نقابية فاعلة بأي حجة كانت يسمح له القانون بالنفاذ منها، لاستبدالهم بعمال آخرين جدد لا يحتاجون لكثير من التدريب والتأهيل والأكلاف المترتبة على ذلك لإدماجهم في مواقعهم الوظيفية الجديدة، وهم الذين لا بد أن يفهموا شروط معادلة استمرارهم في عملهم، القائمة على السكوت والقبول بكل الشروط والأجور التي يعرضها مشغلهم عليهم، وإلا تم استبدالهم بغيرهم.
وهو الواقع الذي تم ترسيخه من خلال تهشيم النقابات في الغرب منذ صعود نهج الليبرالية الجديدة Neo Liberalism في حقبة مارغريت تاتشر في بريطانيا، ورونالد ريغان في الولايات المتحدة، منذ مطلع ثمانينيات القرن المنصرم، والتي كانت نقطة انفلات الرأسمالية التقليدية من كل عقال اجتماعي كان ينظمها في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وفق النهج الاقتصادي الذي اختطه العالم الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز في اتفاقية بريتون وودز في العام 1944، والذي قام بترويض الرأسمالية ومنحها دوراً تنظيمياً واجتماعياً لا بد منه لضمان استقرار المجتمعات الغربية وعدم العودة إلى العجلة الشيطانية للحروب الكونية، على شاكلة الحربين العالميتين الأولى والثانية، وهو الدور الذي كان تمظهره العياني المشخص في الغرب فيما عرف بدولة الرفاه Welfare State، وهي التي يمثل التراجع عن مفاعيلها بشكل ممنهج أحد أهم ركائز مشروع الليبرالية الجديدة الذي نعايشه راهناً معبراً عن أقبح أشكال الرأسمالية الاحتكارية الوحشية المعولمة.
واستبدال الموقع الاقتصادي للقطاعات الإنتاجية في الغرب بقطاعات خدمية تتمركز أساساً حول الخدمات المالية والمصرفية، ينطوي في تكوينه البنيوي والوظيفي على تخليق ذلك المنفذ الذي سوف تتسرب إليه كل الثروات المنهوبة والمسروقة من العالم النامي فساداً وإفساداً، والتي لا بد من تهريبها إلى الخارج لأجل إخفائها وغسيل طبيعتها القذرة، وليس هناك أفضل من المؤسسات المالية القائمة في الغرب، وخاصة في المراكز المالية الكبرى في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا للقيام بذلك. وهي الأموال المسروقة التي لا بد أن تبحث عن أي سبيل للاحتفاظ الآمن بها، ومقاومة تآكلها عبر التضخم الذي لا يقل عن 2% سنوياً عند الاحتفاظ بها بأي من عملات التبادل العالمي، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، والسبيل الأجدى لذلك هو الانغماس أكثر في العلاقة مع تلك المؤسسات المالية العملاقة في الغرب نفسها، عبر استثمار تلك الأموال المنهوبة والمسروقة من دول العالم الثالث عن طريقها بشكل آمن يحافظ، والذي أفضل خياراته يتمثل في الاستثمار في الدين العام لدول الأقوياء وسندات خزائنها الحكومية، حيث إنها الدول الأكثر استقراراً من الناحية النظرية على المستوى الكوني، وهي الديون التي تقوم البنوك المركزية في تلك الدول ممثلة بالاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، وبنك إنكلترا في المملكة المتحدة، والبنك الأوربي المركزي في أوربا، التي تمثل ألمانيا قاطرتها شبه الوحيدة، بشراء تلك الديون الحكومية، وتحويل التزامات سدادها من الدولة التي لا بد لها من القيام بجبايات ضريبية تنجم عن أعمال إنتاجية حقيقية لسداد تلك الديون، لتصبح في عهدة البنوك المركزية التي دورها شبه الأوحد في الاقتصادات الغربية يتمثل في طباعة النقود عبر تخليق أرقام إلكترونية لا تستند إلى أي سند إنتاجي حقيقي فعلي، وإنما فقط إلى الحاجة في السوق المحلية للإمداد النقدي لضمان عدم انخفاض معدلات التضخم، والتي لا بد من الحفاظ عليها بمعدلات تتراوح حول 2% سنوياً في كل الاقتصادات المتقدمة، كشكل آخر من خطة تهشيم مفاعيل دولة الرفاه، إذ إن التضخم لا بد أن يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية لرواتب العمال في تلك الدول بنفس معدلات التضخم، وهو التآكل الذي لا يوازيه أي زيادة في رواتب أولئك العمال بنفس معدلات التضخم، وهو ما يفصح عن نفسه بحقيقة أن رواتب العمال في الاقتصادات المتقدمة بعد تعديلها حسب معدلات التضخم التراكمية خلال بضعة العقود الأخيرة لم يحصل فيها أي زيادة حقيقية منذ سبعينيات القرن المنصرم.
وبالعودة إلى واقع شراء البنوك المركزية لديون دولها الحكومية وتمويلها بطباعة النقود وتخليقها من لا شيء، فإن ذلك يعني فعلياً تحويل كل الثروات المهربة والمسروقة المنهوبة من اقتصادات الدول النامية إلى شرايين الاقتصادات الغربية، دون أي مقابل فعلي حقيقي، سوى قوة تلك البنوك المركزية القادرة على تخليق وطباعة أموال كما تشاء، وهي التي طبعت مبالغ تتجاوز العشرين تريليون دولار منذ العام 2008 لأجل تحفيز اقتصاداتها، في محاولة لإخراجها من التراجع الاقتصادي العميم الذي حل في العام 2008، وهو ما لا تستطيع أي من الدول النامية القيام به، إذ إن عملاتها لا تمثل عملات عالمية للتبادل العالمي، حسب تعريف صندوق النقد الدولي International Monetary Fund والذي تسيطر عليه الولايات المتحدة أساساً ولا بد من الالتزام بشروطه لعدم تعرض أي دولة تخالف تلك الشروط إلى عقوبات وحصار اقتصادي، وبالتالي هي عملات محلية محدود الطلب عليها بحجم اقتصاداتها المحلية، وطباعة نقود إضافية منها لا يمكن أن يسهم إلا في زيادة التضخم إن كانت طباعة النقود غير مترافقة مع زيادة حقيقية في معدلات الإنتاج العياني المشخص في مجتمعاتها، على خلاف حال ما يعرفه صندوق النقد الدولي بأنها عملات صعبة، وهي أساساً الدولار الأمريكي، وبدرجة أقل بكثير اليورو والجنيه الإسترليني، والتي يُمَكِّنُ الطلبُ العالمي عليها كعملات للتبادل العالمي البنوكَ المركزية في اقتصادات الأقوياء السالفة الذكر من طباعة أكداس هائلة منها توازي حجم الطلب العالمي عليها حتى لو لم يكن هناك إنتاج محلي في دولها يوازي تلك الأكداس المطبوعة.
وهو الواقع البائس الذي يعني قيام القطاعات الخدمية المالية في الغرب بسرقة ممنهجة ومقنعة لثروات الدول النامية ومبادلتها بأرقام يتم تخليقها في حواسيب تلك البنوك المركزية دون أي سند إنتاجي لها سوى ذلك المتعلق بالنظام الاقتصادي العالمي الذي دوره الوظيفي الأول هو ترسيخ هيمنة الأغنياء على الفقراء، وزيادة ثرواتهم على حساب المفقرين الذين يزدادون فقراً باضطراد، حتى أصبح بضعة أشخاص من أثرياء العالم الغربي يملكون ثروات تعادل نصف ثروات الكرة الأرضية، بحسب تقرير منظمة أوكسفام الأخير عن التفاوت الاقتصادي العالمي المريع.
ليفانت - مصعب قاسم عزاوي
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!






















