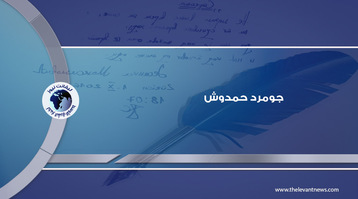-
المهجرون السوريون بين الاندماج والانحلال

تعد الهجرة من الأساليب الحياتية القديمة المتبعة لدى الإنسان وهي ظاهرة ليست بحديثة، إذ إنّ الإنسان كان يهاجر طوعاً أو قسراً بسبب الظروف، البيئية، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية أو الدينية، وفي القرن الحادي والعشرين أصبحت ظاهرة الهجرة الفردية أو الجماعية التي تتسبب بها النزاعات والصراعات المسلحة في الشرق الأوسط خصوصاً، من الظواهر المثيرة للقلق خاصة بالنسبة للشباب بسبب الاندماج السريع بالمجتمعات المختلفة ثقافياً واجتماعياً.
لطالما كان بريق الغرب يخطف أبصار الشباب السوريين، فكان حلماً صعب المنال قبل الأزمة السورية بسبب تشديد القبضة الأمنية عليهم، وخصوصاً من لم يلتحق بالخدمة الإلزامية منهم، ناهيك عن تكاليف السفر الباهظة والإجراءات القانونية اللازمة، بينما اختلف الوضع منذ بداية الحرب في سوريا عام 2011، حيث أصبحت الحدود متاحة للجميع نتيجة الفوضى العارمة التي خلَّفها الفراغ الأمني، وازدياد أعداد مهربي البشر بشكل غير مسبوق، واستغلالهم للأوضاع الأمنية بالاتفاق مع حرس الحدود في الجانب الآخر مقابل مبالغ مالية متفاوتة، فتدفق الشباب باتجاه أوروبا هرباً من بطش النظام ووحشيته، وتحقيقاً لرغباتهم المكبوتة في اكتشاف العالم الآخر الخلّاب، كما اتخذ المتزوجون قرار الهجرة بحثاً عن الأمان والاستقرار لهم ولأولادهم على أمل تأمين مستقبل أفضل، فكانت الهجرة القسرية تكملةً لسلسلة مآسي المواطن السوري الذي عانى خمسين عاماً من السلطة الدكتاتورية القمعية.
يواجه المهاجرون في رحلتهم مخاطر جمة، يعيشون بين الحياة والموت ويبقى مصيرهم مجهولاً إلى حين الوصول للمنفى، يبتلع البحر عدداً كبيراً منهم فيغرقون فيه، وينجو آخرون ويتلقون الصدمة منذ لحظة وطأة أقدامهم الأراضي الغربية الغريبة، تتلقفهم السلطات فور وصولهم ليعاملوا معاملة الجراثيم الغريبة في الجسم، فهم بالنسبة للأوروبيين مجرّد لاجئين هاربين من الحرب، وفي ظنّ مواطني تلك البلاد هم جاؤوا ليصدِّروا حروبهم إلى بلادهم الآمنة، لذلك يتعامل معهم كل من السلطات والمواطنون بحذر، وتفرض عليهم قوانين صارمة، بدءاً بالإجراءات الأمنية مروراً بفرض دراسة اللغة عليهم، وانتهاء بمنعهم من العمل إلى حين يحصلون على الإقامة ويسمح لهم، وهكذا يقضون وقتهم بين المدرسة والدوائر الرسمية لملء الاستمارات، ودفع الفواتير، وإتمام إجراءات اللجوء.
وهناك قسمٌ آخر من المهجّرين السوريين، وهم الأسوأ حظاً، لاجئون يقطنون في المخيمات الموزعة في البلاد المجاورة لحدود الوطن، يتنشقون نسيمه بحسرة بين الحين والآخر، تستخدمهم حكومات تلك البلدان كورقات ضغط رابحة على الدول الأوروبية، ويشكل هؤلاء ثلث عدد اللاجئين السوريين حول العالم، ففي تركيا وحدها يوجد حوالي 4 ملايين لاجئ سوري، وفق إحصائيات أجرتها الأمم المتحدة، أُجبروا على الهروب من بطش النظام أو الفصائل المسلحة التي تكاثرت كالذباب خلال الحرب في سوريا، فانتشروا بحثاً عن حياة آمنة، ووضعت ملفاتهم على طاولات الاجتماعات في الدول التي تتلاعب بهم لنيل مصالحها، بينما تعجز القوانين الدولية "الإنسانية" عن إيقاف الحرب في بلادهم أو عن إنصافهم وحل قضيتهم.
من جانب آخر، تستغلهم بعض الأحزاب لمصالحها الحزبية حيث أُسقطت عنهم الأقنعة المزيفة المدعية بحقوق الإنسان، واستولى المستوطنون على أملاكهم وأحدثت القوى المتصارعة على التراب السوري تغييراً ديموغرافياً لا مثيل له في تاريخ سوريا.
تحت كل تلك الضغوطات يراسل اللاجئون الشباب أهاليهم في الديار، ويحكون لهم عن النعيم الذي هم فيه، يلتقطون بعض الصور بالقرب من المعالم والمناظر الخلابة، ويرسلونها لهم ليطمئنوهم بأنهم يعيشون في رفاهية لا مثيل لها، وبعد فترة في حين يعمل البعض من هؤلاء الشباب بطريقة غير شرعية خفية عن أنظار السلطات، يرسلون بعض الأموال لعوائلهم، أما المتزوجون الذين تتبلور لديهم فكرة الهجرة لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، فمنهم من يهاجر لاختلاف توجهه السياسي مع السلطة، ومنهم من يهاجر بحثاً عن الراحة الاقتصادية التي باتت صعبة المنال في الوطن، ومنهم من يهاجر لتأمين سبل عيش أفضل لعوائلهم وأولادهم وطمعاً بمستوى تعليمي أفضل، وهكذا تتم الهجرة بعد أن يكون الرجل قد أنفق مدخراته وشقى عمره وزوجته للوصول إلى أوروبا، ويستدين البعض منهم المال على أمل أن تتحسن الأحوال في فترة وجيزة بعد الوصول للمهجر وذلك غالباً ما لا يحصل.
يندمج السوريون بسرعةٍ كبيرة بالمجتمع الغربي، خاصة الفئة الشابة التي لم تجد في الوطن ما يعزز فكرة الانتماء، وتلقفتهم السلطات بصدر رحب للاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم، فالقارة العجوز تحتاج إلى الأيدي العاملة والطاقات الشبابية، وتستطيع تسخير طاقات الشباب اللاجئين بضغط القوانين وبأجورٍ بخسة، والمشكلة هنا لا تكمن في السلطات فحسب، بل تكمن بطريقة تعامل هؤلاء الشباب مع الواقع الجديد، وتشبههم بالأوروبيين، وتقليدهم وانخراطهم في المجتمع بطريقة سمجة، والابتعاد عن ثقافتهم الأم، حتى إن اليافعين منهم ينسون لغتهم الأم بعد فترةٍ وجيزة، ولا يعمل معظم الكبار على التسويق لقضاياهم في المهجر، ويعيشون بلا هدف، أما البعض الآخر فإنهم يستغلون قضايا الشعب لمصالحهم الشخصية، ويبدؤون بالمزاودات من منبرهم العالي، ولكي لا نكون سوداويين حقاً فهناك شخصيات استطاعت نشر الوعي في تلك البلاد ولو كان على الصعيد الفردي مستغلين بذلك حرية الرأي والتعبير وساهموا في نشر وايصال معاناة الشعب السوري للمجتمع الأوروبي المهتم بالأزمة السورية.
وسعى آخرون للاستفادة من وجودهم في أوروبا لتحقيق حلمهم في اكتساب مهارات مختلفة وأيضاً الدراسة واستكمال ما بدؤوا به في الوطن، آملين أن يستثمروا مهاراتهم يوماً ما في وطنهم الأم، كما استطاعوا بناء علاقات تمنحهم مكانات خاصة في المجتمع الغربي.
أخذت الهجرة السورية شكلاً مختلفاً كون المجتمع السوري بشكل عام عانى على مضض من سياسات القمع والسلطة الدكتاتورية لعقود، فكان المواطن السوري كمن خرج من سجن المنفردة إلى النور، فعانى خلال رحلة خروجه من العمى المؤقت بسبب النور الساطع المفاجئ، ليتعرف إلى عالمه الجديد، وما حدث هو عدم استطاعة البعض الاستفادة من هذه الفسحة من الحرية، فالمهجّرون السوريون هم أشجارٌ ذابلة اقتلعت من جذورها، غُرست في ترابٍ غير صالح للزراعة، وسُقيت بالألم والمعاناة، ورغم ذلك تبقى الأغصان الغضّة تتطلع للشمس، عساها تنجو من اليباس.

ليفانت - أفين يوسف
العلامات
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!