-
أيُ فكرٍ وراء فكرة المناطق الحرة
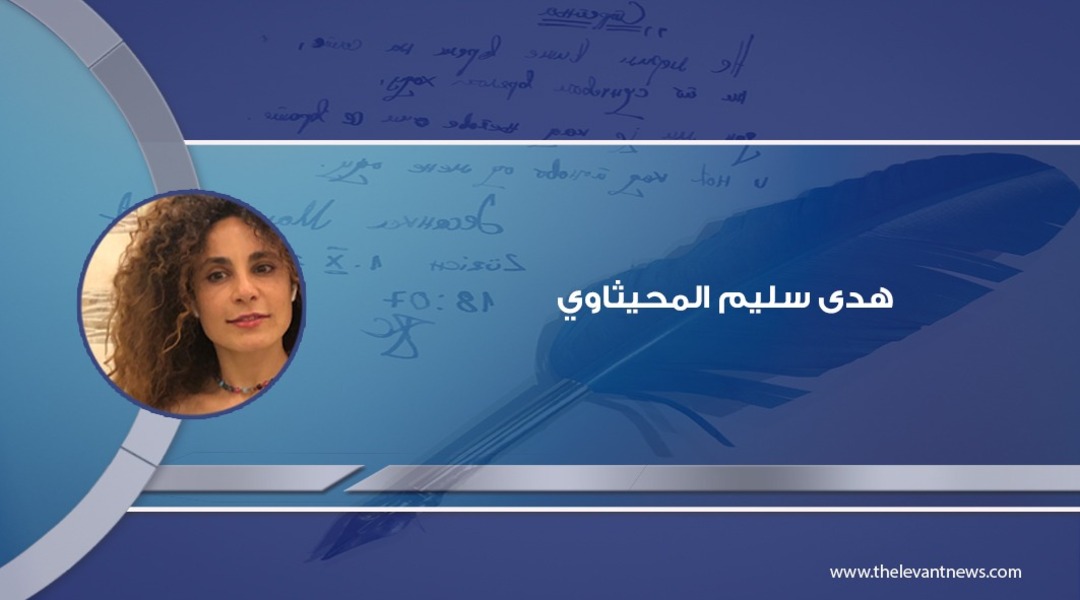
وحدها الاستراتيجية وما تنطوي عليه من سياساتٍ وأساليب تقف وراء ذهنية الاقتصادي وتميزها عن عقلية التاجر التي تهتم بتحقيق المكاسب والأرباح ومضاعفتها، وتقتصرُ رؤيتها على تخطيط مشاريعَ وتسوياتٍ مؤقتة، ينطبقُ عليها نفسُ منطق التسويات السياسية، التي يمكن أن تكون حلاً لمشاكلَ مؤقتة ومحدودة، دون أن تتمكن من تقديم حلٍ ناجع ٍ وشافٍ، فتُبقيه ساكناً في الوقت الحالي، لكن معرضاً للانفجار في أي وقت حالَ زوال ضامني هذه التسويات.
طُرِح في الأيام الماضية تصورٌ يفترضُ الذهنيةَ الاقتصادية مَرجعاً، يسعى إلى رفاهية الشعوب وتحقيقِ تطورها الاقتصادي، لكنَ خطأً قاتلاً أخرجه من إطار هذه الذهنية، وأدخله في إطار ذهنية التاجر المُروجِ لحلولٍ، لا ترقى إلاَ أن تكون تسوياتٍ مؤقتة وجزئية وبعيدة عن الواقع حتى وعن مشكلاته الرئيسة.
إنَ أي طرحٍ اقتصادي لا يأخذ بعين الاعتبار النظام السياسي وأحواله ومتطلباته، بل وأكثرُ من ذلك، أنَ الرؤية الاقتصادية بالمحصلة هي ترجمة لرؤيةٍ وتطلعاتٍ سياسية، تضمنُ لها أوراقَ تفاوض ونقاطَ قوة تُساعدُ في تحقيقها، وإلاَ تحولت إلى وبالٍ حتى لو انطلقت من فكرةِ تحقيق مكاسبَ، وهنا نستذكرُ تجربة جمال عبدالناصر في تطبيق الاشتراكية من حيث أحقيتها كفكرة، لكن كارثيتها في نسف التنافس الاقتصادي الذي هو عمادُ تطور أي اقتصاد، وكيف كانت سبباً في هدم الاقتصاد( الحر) وكيف لم تقم له قائمة منذ ذلك الوقت، خاصةً في سوريا.
مِنَ الطرح الذي تمَ طرحه من خبيرٍ اقتصاديٍ عربي، يروجُ لمناطقَ "حرة" في أكثر من بلدٍ عربي، سنُفند الجزء الخاص بسوريا كونها الجزء الذي أَخبره، وبالتأكيد سيكون هناك مَن هم أَدرى بشعاب الدول الأخرى المَعنيةِ ليتحدثوا عنها.
أولاً، إنَ طرح ثلاث مناطق حرة سورية، وتصنيفها بناءً على الانتماء الديني! خاصةً أنَ مصطلح المناطق الحرة هنا لم يقتصر على المفهوم المتعارف عليه اقتصادياً، بل تعداه إلى أن يكون سياسياً وأمنياً، هو طرحٌ يمتلك كافة مقومات التقسيم، مع رفض التسمية واختيار تسميةٍ أكثرَ عصرية، لتكون "مناطق حرة".
سأذهبُ أبعد مما ذهب الخبير الاقتصادي لأقول: أنه لو أعترفَ بأن الطائفة والانكفاء لها، مازال ينخر في بُنيتنا وتكويننا (وهذا جداً طبيعي في ظل غياب تَشكُل الدولة الوطنية)، ونحتاج إلى تحليل وتفكيك انتماءاتنا أكثر فأكثر حتى نتمكن من إخراج كافة الرواسب العالقة والتي ستعيق أي بناءٍ صحيح، لكنتُ سأوافقه في هذه الفكرة، أمَا تغليفها بغلافٍ اقتصادي لتُقدَم وكأنها هدية، فهي ليست سوى دسٌ للعسل في السم، ومحاولة التفافية للإبقاء على الحالة دون علاجٍ لها.
ثانياً وهو الأهم والأساس، أنه لو تم إعمالُ الذهنية الاقتصادية قبل ثورات الربيع العربي، وقبل إدراك الشعوب العربية عموماً لكيفية تعامل السلطات معها ومع مطالبها بالكثير من الإنكار والعنجهية ومقابلتها بالرفض والتعنت، ربما كانت ستكون خطوةً في الاتجاه الصحيح نظراً لاتجاه العالم للاقتصاد حتى في حروبه. لكن الثورات في العالم العربي طرحت الكثير من القضايا ووضعتها على الطاولة، وأضحى من الصعوبة بمكان تجاهلها أو التغافل عنها والانتقال لتحقيق الاستقرار في المنطقة قبل معالجتها، إذ بات مُدرَكاً بأنَ الحل هو إنهاءُ حالةِ الفساد وتطبيق العدالة الاجتماعية التي ستحقق الرفاهية الاقتصادية، أي أي رفاهية اقتصادية ستكون نتيجةً لتحسيناتٍ سياسية كي لا نقل رفاهية، وإلاَ ستكون الحلول المطروحة في إطار عقلية التاجر التي تُقدم فتات الخبز بدلَ المطالب الأساسية.
يفترض الخبير أنَ هذه المناطق "الحرة" ستوفر بدعمٍ من قوات التحالف، الحمايةَ لساكنيها من هجمات الجماعات المتطرفة، دون أن يذكر لنا المانع إذاً، من حماية هؤلاء المدنيين من الجماعات المتطرفة وغيرها من الجماعات التي ترتدي رداءة علمانية بممارساتٍ أكثر إجراماً، مع إبقائهم تحت مظلةِ منطقةٍ واحدة موحدة! مع العلم أنَ بقاء هذه التهديدات واستمرارها هو احتمالُ انهيارٍ لهذه المناطق قبل بنائها.
إنَ فكرة المناطق الحرة، هي منطقة جانبية من المناطق الأساسية للدولة، لتسكين حالات وحاجات العبور فقط، وهؤلاء الناس الذين يطالبون بحقوقهم، ليسوا بعابرين ولا بمارقي طريق، إنهم أصحاب المناطق الأساسية للدولة.
لو كانت الفكرة هي منطقة حرة مؤقتة، تكون عِماداً لنهوض الدول المُنهارة ووسيلة لإعادة اللاجئين أيضاً مؤقتاً ريثما يعودوا إلى منازلهم، كانت لتكون فكرة محط احترام ووجاهة، وأنا من الأشخاص الذين طرحوا فكرة مُدن "بول رومر" المُستَأجَرَة لتكون هذا العِماد والوسيلة.
لابدَ من التأكيد أنَ الذهنية والحل الاقتصادي، هو المَخرَجُ الأكثرُ أمناً وأماناً للمعضلة السورية، خاصةً مع صعوبة وتحديات تطبيق العدالة الانتقالية، لكن من المهم جداً أن يتحلى مَن يطرح أي فكرة أو نظاماً اقتصادياً بذهنية الاقتصادي أولاً، التي تُدرك استحالة بناء نظامٍ اقتصادي بمعزلٍ عن السياسي، و أن يكونَ صاحبُ الطرح مؤمناً بحقوق ومبادئ الشعب الذي يتحدث عنه ثانياً، كي لا يتغاضى طرحُه عنها، فيتحول صاحبه إلى أداة تنفيذ، بدلَ أن يكون أداةً مُساهِمة في تقديم الدعم والعون ووضع خبرته في خدمة أبناء بلده، وهذا يحولُ بنا إلى تساؤلٍ عن دور المثقفين ومسؤولياتهم اتجاه بلدانهم وما يكتنفها من مشاكلَ وهموم.
ليفانت : هدى سليم المحيثاوي
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!























