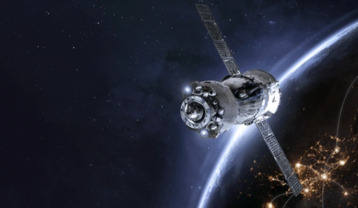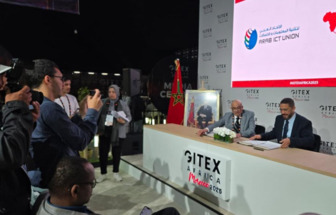-
ذعر الكتابة: الكاتب السوري النموذج الذي لا يعرفه أحد

أنا لا أكتب حتى أصبح مشهورة وتتحدّث عني الصحف وتجري محطات التلفزة معي اللقاءات، وأحقق المبيعات. هذه الصورة المثيرة للغثيان، ترافق اليوم أغلب الساعين صوب عالم النشر، ويبدو النشر بحد ذاته، ورؤية اسم الكاتب على أغلفة الكتب ثم في عناوين الصحافة، هو الهدف الأصلي، وكأنّ فعل الكتابة نفسه، صار غائباً، أو فاقداً معناه الجوهري.
أن يكون أحدنا كاتباً، ولن أضيف صفة "حقيقياً"، لأنه ليس هناك كاتب حقيقي وآخر غير حقيقي، فإن هذا يعني استمرار القلق المصاحب لتفكيره، ورغباته الشديدة في الكتابة، والتي تتحول إلى مرض لا في ارتباك مشاعره وأفكاره فقط، بل يظهر في بدنه.
حالة من الألم التي يرافقها ضيق التنفس، وأنا أشاهد الأخبار الأخيرة، فأشعر بذهول لم أتخلص منه خلال سنوات الحرب الطويلة هذه، والتي تبدو كأنها كابوس دون نهاية، لا أعرف فعلاً متى نستيقظ منه.
أعيش هذا الصراع العنيف، المدمّر، بين عوطفي، كإنسانة، خاصة كامرأة، وأنا أشاهد عشرات التوابيت التي تخرج يومياً من سوريا، ومؤخراً في الحسكة، التي مات الكثير من أبنائها وبناتها، في الاقتتال بين سجناء داعش وقوات سوريا الديمقراطية.
عاطفياً، أنحاز لفريق الحسكة، كونهم أبناء بلدي، وكونهم أصحاب قضية، وكونهم يقاتلون على أرضهم، ضد اعتداء جاء إليهم من الخارج، لتنفيذ أجندات لا تخصّ هذا البلد: الخلافة الإسلامية.
عاطفياً أبكي، كعشرات الأمهات والأخوات، والجارات، اللواتي يشعرن بألم جاراتهن، بل بألم نساء لا يعرفوهن، لكنهن يفهمن ذلك الألم.
أما عقلياً، وهنا يتدخل صوتي الكتابي، بما أنني كاتبة أيضاً، تقتلني الرغبة في فهم ما يحدث، كي يتوقف عن الحدوث، ولا يبدو مشهداً مألوفاً نعتاد عليه: يموت أبناؤنا، فنخرج في جنازاتهم، نقيم الحداد على أرواحهم، ثم سرعان ما تبدأ المعارك من جديد، ويسقط الجديد من الأبناء.
حتى متى؟ ولماذا؟ وكيف نوقف هذه الحرب؟ هذه أسئلة تبدو بديهية، وأحياناً غبية، وأحياناً، بل دائماً، تعجيزية، دون جواب.
الجواب بسيط جداً: ثمة من يريد هذه الحرب، وهذا الفريق، هو الذي يحدد متى تنتهي الحرب، أما لماذا؟ فالجواب كذلك لديه. لهذا تبدو الأرض السورية بمثابة مسرح للمعركة.
لطالما استغربتُ من ارتباط كلمتي المسرح والحرب. كيف تكون الحرب الحقيقية، التي يموت فيها البشر؟ خشبة مسرح.. ولكن الحرب السورية هي مسرح مرتّب بأيدٍ تدير اللعبة بدقة.
دقة اللاعب الذكي، ذي المصلحة في هذه الحرب، وربما صانعها، تتمكن من تحديد إحداثيات تواجد أخطر زعيم إرهابي في العالم، في بيت في محافظة إدلب السورية، فتلتقط القوات الأمريكية هذه الإحداثيات، ويتم الإنزال الجوي، ويتم القضاء على الإرهابي، ويسقط معه بعض المدنيين، وبعض العسكريين من السوريين "من قسد خاصة "، أما الأمريكان، فلا يصاب أحدهم بخدش واحد.
عاطفياً، أشعر بالفرح.. ولو كنتُ في سوريا، في الحسكة مثلاً، لزغردت ناسية حداد جاراتي اللواتي دفنّ أبناءهن البارحة. ثم ينهض عقلي الروائي، ليفرض عليّ الألم والإحساس بالغثيان وضيق التنفس، فيسألني: ولكن ما هو الرابط بين أحداث سجن غويران، وفرار سجناء داعش، وبين عملية أطمة في ريف إدلب؟
عقلي يكاد يقتلني وأنا أفكر بما يحدث، ونرجسية الكاتبة في داخلي، تلك الحالة الأقرب إلى الدونكيشوتية، تجعلني أفكر بالتحليق صوب البلاد التي هجرتها قبل الحرب بسنوات، لأكون داخل "المسرح" وأفهم اللعبة.
الكتابة من داخل الحدث
في بداية الحرب السورية، حين كتبتُ روايتي طبول الحب، عرفتُ أن هناك الكثير مما ينقص هذه الرواية. كان ينقصها أن أكون على الأرض.
نسّقت مع أحد الأصدقاء آنذاك، أن أدخل إلى سوريا، عن طريق ما يُدعى بالجيش الحر، وكان ذلك الصديق أحد المتعاونين معهم. كانت لدي ثقة كبيرة أنه قادر على حمايتي، لأدخل وأرى وأفهم، ثم أنقل مشاهداتي فأكتب.. وأنا أعيش أسطورتي الخاصة، أن الكتابة ربما تغيّر العالم.
مرّ الوقت سريعاً، وكما يعرف العالم بأجمعه، لا السوريون فقط، بأن الأحداث في سوريا تتلاحق بوتيرة، لا نكاد فيها نستوعب حدث البارحة، ليأتي حدث جديد فننشغل به. ووجدت نفسي، ضمن تلاحق الأحداث، أتحول إلى خصم لهذا الصديق، دون أن أفهم السبب.
حاولت التواصل معه لأستفسر عن سبب حذفه لي من مواقع التواصل الاجتماعي، فتجاهل طلبي. كان عليّ أن أخمّن، أن فريقاً مجهولاً، أوعز إليه بفكرة ما، فاعتبرني من خصومه، لأسباب إثنية، ولم تغفر لي سوريتي لديه، فأنا الآن، بالنسبة له، ولغيره الكثيرين: كاتبة كردية.
في قرارة نفسه، اعتبر ذلك الصديق، أن على الكرد مساعدتي لتأمين سلامة وصولي إلى الداخل السوري، لأن كتابتي في الآخر، ستكون في مصلحتهم.
اليوم، وبعد قرابة عشر سنوات على الحادثة، أشعر بالامتنان لصديقي الذي تخلّى عني، لأنه لم يضللني، فيسلمني كرهينة لخصوم الكرد.. كان يستطيع أن يفعل، وكان من السهل أن يتم أخذي كرهينة، بصفتي فرنسية أيضاً.
إن صديق الأمس، يكرهني اليوم، لأسباب خارجة عنا نحن الطرفين، لأنّها الحرب.. التي جعلت من الكثير منا، خصوماً لغيرهم، دون اختيار. لقد صار لدي الكثير من الخصوم في هذه الحرب، كما لغيري دون شك.
عاطفياً إذن، أتفهّم صديقي، فهو إنسان تحركه مشاعره وغرائزه، وهو ينشر اليوم شعارات قاتلة محرضة على الكراهية، وهو ينعم ببيت آمن خارج سوريا وبمرتب مريح، لا يعاني مما يعانيه السوريون في الداخل من أزمات الماء والكهرباء والغاز، بل والخبز.
أما روائياً، فلا يسمح لي هذا الرأس بالتعامل مع الأمر على أنه سلوك عاطفي انفعالي يقود المجاميع البشرية، خاصة في الحرب، ولا تريح رأسي مقولات غوستاف لوبون عن سلوك الجماهير الغاضبة في كتابه سيكولوجيا الجماهير. بل يحثّني للذهاب أبعد بالتفكير. هذا التفكير الذي سيظل قاصراً، طالما أنني خارج المسرح. هل هذا يعني أن عليّ مغادرة موقعي كمتفرجة من فرنسا، إلى الدخول في الملعب؟
بطريقة ما، فإن الجواب الذي يقدمه عقلي الروائي هو نعم. علي الاقتراب من اللاعبين، ودخول الكواليس، والإصغاء إلى التمارين التي تتم بمهنية شديدة، حي يستعدّ كل لاعب للتدرب، قبل الذهاب إلى الموت.
لكن هذا يعني، أيها العقل الروائي، أنني قد أموت في المسرح ذاته، فهو مسرح الحرب، والحرب المدارة بدقة يمارسها طرف لا تفهمه أنت ولا تتصوره، لا تعبأ بك! أجيب عقلي ذلك، فيسخر مني قائلاً: أتشعرين بالخوف؟ حسناً أيتها الكاتبة، كيف إذن تسمحين لنفسك بالاعتقاد بإمكانية تغيير العالم عبر الكتابة؟ قبل التغيير، عليكِ بالكتابة، ولتكون كتابتك حقيقية، عليكِ أن تكوني في المكان، وعليكِ أن تراهني على الحياة، وتتقبلين فكرة الموت هناك، في مسرح الحرب.

ليفانت - مها حسن
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!