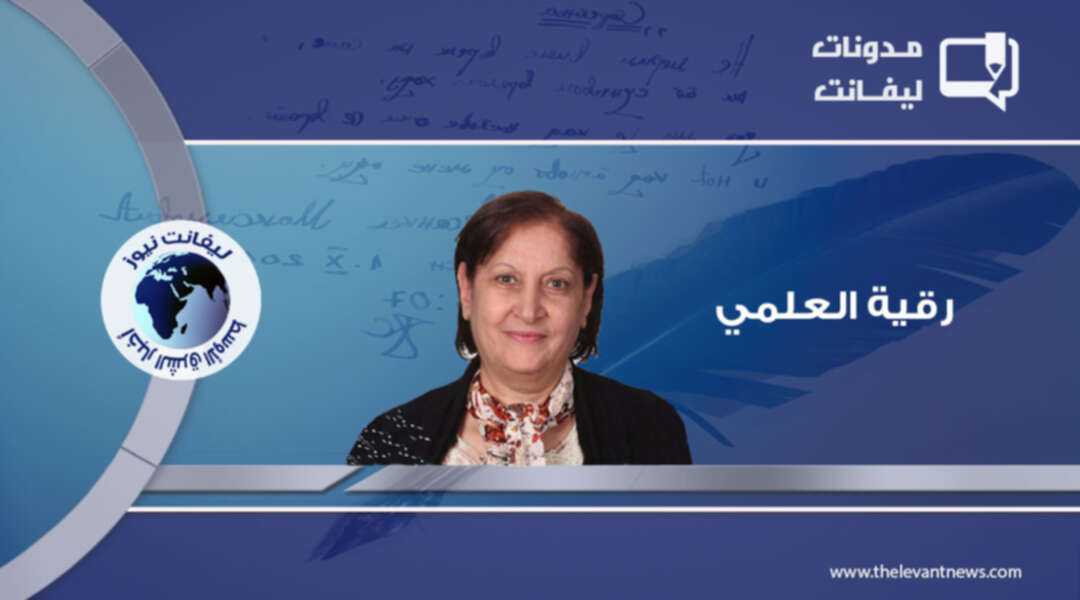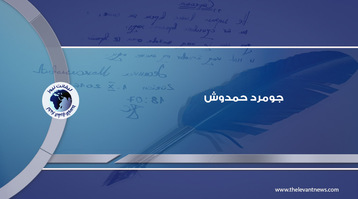-
دواعش المغاور ودواعش الدوائر

بعض المسمّيات لا تؤكّد حقيقة المسمّى أبداً، فمثلاً نقرأ لوحات دلالة على بعض المطاعم تشير إلى وجود أطعمة فاخرة، وهي تقدّم أسوء ما هو موجود، وبعض الشركات تتميّز بوجود أجمل الموظفات لكنها تتعامل مع الناس عن طريق النصب والاحتيال، وهكذا.. حتى مع كثير من الدوائر الحكومية.
في إحدى محافظات العراق، مستشفى حكومي يطلق عليها اسم مستشفى الإمام الصادق، ومعروفة باسم المستشفى التركي، لكنها تفتقر لخُلق الصادق، ونظافة تركيا، تتميز ببنائها الحديث الفاخر ظاهرياً، لكنها على العكس من ذلك تماماً من الداخل، أمّا المستشفى التركي في البصرة فإنّها تقع في منطقة صحراوية مقابل حقول النفط، ولحدّ الآن مهجورة تسكنها الأشباح، وهي من بين عشرة مستشفيات في العراق.
لنبدأ برواية عن حالة طارئة واحدة قبل جائحة كورونا سبقتها حالات وحالات في المستشفى الأولى، ونكمل بأحاديث أخرى كي تكون الصورة واضحة للعيان:
تعرّضت إحدى الطالبات الجامعيات لحالة إغماء مفاجئ، وهي في إحدى قاعات الدراسة ذات مرة، ما أدّى إلى حالة هبوط حاد في ضغط الدم، وبتعاون الطلبة والأساتذة تم نقلها إلى المستشفى التركي بسيارة إسعاف تابعة للمركز الصحي هناك، لم يكن أي شيء يمكن تقديمه من خلال المسعف إلى المصابة، سوى تكرار قياس ضغط الدم، إلى أن حدثت اختلاجات عضلية وتشنجات قوية لدى الطالبة ما أربك الجميع (المسعف وأحد الأساتذة وطالبة رافقت صديقتها للمستشفى).
وصلت المصابة وتم الاتصال بذويها ووصل الأهل والطالبة في حالة إغماء شديدة، التحقت مجموعة أخرى من الطلبة للاطمئنان على زميلتهم، ولحدّ الآن لا طبيب ولا طبيبة، الأستاذ يبحث من جهة على طبيب وذوو الطالبة من جهة أخرى، الى أن تم العثور على أخصائي يتفقد أحد مرضاه الخاصّين، جيء به للطوارئ فطلب والد الطالبة منه معاينة ابنته. بكل برود واستهزاء –ربما– قال الطبيب: اطمئن لا يوجد شيء، وأعطيك ضمان لمدة ١٥ سنة بسلامة حالة ابنتك، اطمئن ولا تخف.
وبدون أي فحص أو تدقيق، خرج الطبيب لأنّ الدوام شارف على الانتهاء، كما أنّ هذه ليست مريضته، إلى أن جاءت طبيبة جديدة وطُلب منها فحص المصابة قالت: وماذا أفعل؟ منذ متى وهي هنا؟ لماذا لم يفحصها بقية الأطباء؟
انهالت الأسئلة على المساكين، وكأنّهم السبب في كل ذلك، تنازلت الطبيبة -جزاها الله كل خير وكثّر من أرزاقها- وكتبت قنينة مغذٍّ للمريضة وانتهى الأمر. انتهى الدوام وتم إخراج مرضى الطوارئ وفُرشت موائد الطعام حيث رائحة البرياني والدولمة والكبة الكباب وما لذّ وطاب، الممرات تعجّ بالأوساخ والأتربة، وحاويات النفايات مليئة بالقذارة، والجميع لا يعرف إلا بقطع تذكرة (أم) ثلاثة آلاف دينار، أو إخراج مريضك على مسؤوليتك، وأنّه لا يعرف إجابة عن أي سؤال، واذا تكلم يقول: أخي اذهب واشتكِ علينا؛ لم تكن هذه إجابة العاملين فقط، بل هي أيضاً مواساة الأطباء ونصائحهم لذوي المريض، وكأنّ المشكلة قد انتهت بذلك.
حتى (الكانيولا)، وهي قناة إدخال السوائل عبر الوريد للجسم، تم وضعها للمريضة بشكل خاطئ، ولولا انتباه ذويها حين انتفخت المنطقة تحت الجلد لكان جميع محلول المغذي يبقى هناك، وبدلاً عن فائدته –إن كان مفيداً– سيسبب ألماً وحرقة تحت الجلد.
الشيء الوحيد في المستشفى التركي هو جمالية البناية وألوانها وزجاجها الفاخر، والملابس الأنيقة والجذابة تحت الصدرية البيضاء للمنتسبات، ورائحة العطور الزكية لهن، وألوان المكياج الزاهية، أمّا غير ذلك فحدّث ولا حرج، والأدهى من ذلك في أحيان كثيرة يُطلَب من المريض -بحالته الطارئة- الذهاب للمختبر لإجراء التحليل، والذي غالباً أيضاً يقال له غير متوفر وعليك إجراؤه خارج المستشفى.
الكلام يطول والقصص كثيرة، ولنعد إلى طالبتنا وماذا حصل لها بعد انتهاء قنينة المغذي، لم تغلقها الممرضة بل أغلقها الوالد لأنّها كانت منشغلة بتصفح الفيسبوك والرد على التعليقات أو مشاهدة اليوتيوب، أو رسائل تعزية ترثي حالها لصديقةٍ، وما تعانيه من مشاق العمل، ولا يختلف ذلك عند بعض الأطباء والطبيبات، وهنا نقدّم شكرنا لمارك صاحب تقنية الفيس بوك، لأنّه ساعد أصحاب الفراغ بإشغال أوقاتهم، لاسيما وهم في العمل، حيث لا عمل.
الدوائر الآن مجرد مكان ممتع لقضاء الوقت واستلام راتب آخر الشهر إن توفرت السيولة النقدية، لذلك نجد ضياع كثير من الوقت والجهد والأموال من قبل المواطن البريء لإنجاز معاملاته التي لم تنجز، يبحث عن الشرفاء كي يساعدوه فيصدّه الفاسدون، صلّى لله من أجل أن يخلّصه من داعش الموت، وإذا به يقف أمام دواعش من نوع آخر أينما ذهب، لم تسلم منهم لا مستشفى ولا مدرسة ولا مؤسسة أو شركة، ولا تجارة أو صناعة أو زراعة.
تحوّل الدواعش من المغاور الى الدوائر، قلّة من المخلصين في الحكومة والشارع تسعى لإنقاذ الجماهير وخلاصها من الدواعش، وإذا هم يتناسلون بأشكال وألوان شتّى، ولم يستطع أحد بعدُ منعهم.
دعا الطيبون الله أن يرزقهم المطر، فأغاثهم ببركاته ولم يبخل سبحانه وتعالى، وإلى أيامٍ تبقى تئنّ مناطق الفقراء والبائسين من ألم الفوضى وطفح مياه الأمطار التي لو استثمرت بشكل جيد لما احتجنا الاستجداء من تركيا وايران، في حين تتجمّل المناطق الراقية بعد أن يغسلها المطر، ويظهر لمعان جدرانها وشوارعها بوضوح بارز، لأنّها مكتملة الخدمات.
لم أنهِ قصتي مع الطالبة بعد، لأنّها تطوّرت بشكل جديد، فقد ثبت خطأ نظرية الطبيب الأخصائي حين أعطى ضمان صلاحية بالطالبة لمدة خمسة عشر عاماً، بطلة النظرية بعد أن أخذها ذووها إلى عيادة طبيب اختصاص، وبعد إجراء التحاليل المخبرية والفحوصات تبين إصابة الفتاة بالتهاب جرثومي حاد في المعدة وفقر دم شديد، ونقص في مادة الكالسيوم والزنك وفيتامين دي الثلاثي، كل ذلك هو السبب بحالتها تلك التي قال عنها طبيب المستشفى التركي إنّها صالحة لمدة ١٥ سنة، وكأنّها علبة سردين، أو أحد قناني (طرشي الحبوبي) المعتّق الشهير في مدينة النجف العراقية أو (حلاوة دهين أبو علي الشهيرة) التي صمدت الوحيدة على الساحة ولم يعبث بها الدواعش.
قال الأخصائي: “يجب أن تستمر المريضة على العلاج لمدة شهرين وعلى نظام غذائي خاص”. يقول والد الطالبة: “حَدَثَتْ نفس الحالة لابنتي هذه قبل أسبوعين، ونفس الإجراءات حصلت معنا، ولأنّ الوقت كان متأخراً ليلاً، صدّقنا كلام الطبيبة التي قالت إنّ السبب هو الدراسة أو عوامل اضطهاد نفسي تعرّضت لها، الأمر الذي دعانا بعدم مراجعة مختصّ بالموضوع، علماً كانت ابنتنا في عطلة نهاية السنة وليس هناك أي اضطهادات نفسية أو سوء معاملة، لأنّها صغيرتنا المدللة، ولأنّنا لسنا خبراء بصنعة الأطباء، وطلاسم كتاباتهم عملنا بالنصيحة وأمْرنا إلى الله وحده لا شريك له.
أثارتني كلمات مسؤول كبير قبل فترة حين قال في لقاء تلفزيوني: “علينا أن نتخلص من دواعش الدوائر بعد أن تخلصنا من دواعش المغاور”، وهذا ما دفعني جعله العنوان والمدخل للوقوف على أسباب ذلك هنا، وإن كان الفساد الإداري والمالي له الأثر الأول؛ فأين سلطة الرقابات وأين المفتشيّات، وأين رجال الدين أصحاب الكلمة المسموعة في خطب الجمعة، وعلى مدار السنة التي لا تخلو من مناسبات دينية ووطنية وإنسانيّة وشعبية، ومهرجانات لا يخلو العراق منها يوماً؟
فالمولات وحدها لا تنعش البلد ولا تضمد الجراح، وبهرجة ألوان المدارس إن تم صبغها فلا تطور التعليم، والزجاج التركي وحده لن يوصلنا الى ما تقدّمه المستشفيات التركية في تركيا، وكأنّها فندق خمس نحوم، ولقد رأيت ذلك بعيني قبل ثلاث سنوات في تركيا، حتى طعام المرضى كأنّه يقدّم في مطعم فاخر، تُستبدل الشراشف وتنظف الحمامات صباحاً ومساء من خلال متابعة وإشراف وتسجل الملاحظات بسجل يومي، وتوقع العاملة المنظفة، وأول شيء في العراق هو سؤال العامل عن (الإكرامية) قبل اي عمل يقوم به، وبعض المستشفيات لا تحتوي إلا كرسياً متحركاً واحداً لمرضى الطوارئ أو كبار السن، وبعجلات معوجّة، أو متكسرة، بالكاد تُجرّ بالأيدي وكأنّها عربة غضب حمارها عنها واستحمر.
ورأيت في مستشفى حكومي لدولة مجاورة كيف بقي كادر التمريض مع أحد المرضى بعد نهاية الدوام الرسمي لأنّ المريض كان يجب أن يبقى ساعتين أخريين لكمال فحص آخر، وقياس جديد متكرر للضغط، ويتم التأكد وإبلاغ الطبيب، وبعدها يسمح له بالمغادرة.
ومثل ذلك أو أحسن شاهدته في المملكة العربية السعودية، فالأدوية وطنية المنشأ عالية الجودة، أو من مناشئ عالمية رصينة، وفي العراق أدويتنا صينية المنشأ أغلبها، أو مقلدة المنشأ لا تفي بالغرض، فقط لإفراغ الجيوب.
في مستشفياتنا يُترك المريض لا يعرف ما يصنع، ويغادر الجميع قبل نهاية الدوام، حتى ورقة الإجازة المرضية تحتاج لمعاملة مطولة ودفع رسوم ضريبية، وأحياناً واسطة شخص هناك، أو اتصال هاتفي مع صديق كي يتم التوقيع على صك الغفران (الإجازة).
قبل مدة اتصلت بي إحدى الصديقات من فيلادلفيا بالولايات المتحدة معتذرة عن قطع اتصالها الهاتفي معي لأن دورها جاء لتأخذ صورة أشعة لساقيها، وكنت أظنّ أنّها أصيبت بمكروه، وحين أكملت كل فحوصاتها الطبية والشعاعية اتصلتْ وسألتها عن السبب فقالت لأنها تعبت في اليوم الماضي من اجتماع كان للناطقين بالعربية مع سيناتور الولاية، وخافت أن يكون هناك شيء ما فيها فذهبت للاطمئنان، بينما في مستشفياتنا العراقية يكون المريض بحالة حرجة طارئة، أو مكسور الرجل ويطلب منه تصوير شاشة عرض الصورة الشعاعية بجهازه الموبايل وعرضها على الطبيب ليتأكد منها، أو يعيد قراءتها، ولو كانت شاشة الموبايل مثلاً مخدوشة او مكسورة جزئياً او مفطورة فماذا سيكون قرار الطبيب؟ هل هناك كسر، أم فطر، أم ماذا؟ لماذا لم تتعلم إداراتنا الطبية ومسؤوليها من الأمريكان؟ أليسوا هم من حرّر العراق فرضياً وجاؤوا بالديمقراطية منقذاً حسب قولهم؟ لماذا تعلم المسؤول اللصوصية من عصابات الجريمة الأمريكية ولم يتعلم المهنية والخبرة من أصحاب الخبرة؟ لماذا ولماذا؟.. إنّها مجرد تساؤلات طالما سألها غيري، وأشار إليها الإعلام مطولاً.
الأعذار دائماً جاهزة: قلة الكادر، قلة الموارد المادية، ونقص الأدوية، وهروب عمال التنظيف الوقتيين بسبب عدم دفع الأجور، ولا تعيينات جديدة بسبب عدم إقرار الموازنة.
وكل يوم نسمع بتعيين من هبّ ودب من خلال ما يعرف بطريقة الحذف والاستحداث، وللمعارف فقط؛ فكيف يعقل حذف درجة سائق واستحداث درجة ملاحظ بدلاً عنها؟ الأولى تعيين سائق بدلاً عن التحجج لاحقاً بقلة السائقين، وتعيين موظف خدمة بدلاً عن تعيين محاسب، وتعيين مدرس بدلاً عن تعيين موظفة في القسم القانوني، وهي خريجة إعدادية صناعة قسم النجارة مثلاً.
وأخيراً، تذكّرت صديقاً لي كان يحب صدام حسين ويردّد هذه العبارة دائماً: العراق شعبٌ عظيم يفتقر لقائد عظيم، ويبدو أنّه رغم حبه لصدم لم يكن مقتنعاً به، وأخيراً هاجر واغترب، وقد تكون هذه هي الحقيقة التي يبحث عنها الجميع: القائد العظيم كي يخلصنا من دواعش الدوائر، وللإيضاح لا أقصد عودة صدام من جديد، لأنّه لن يعود أبداً كي لا أُتّهم بأنّني من أعوانه، ولن أنسى كيف استضافني صدام ذات يوم لمدة نصف سنة في سجنه الشهير (الشعبة الخامسة)، لكنني إلى الآن لم أكمل معاملة السجناء السياسيين لقناعتي بأنّ العراق كان سجناً كبيراً، لكنه أصبح الآن أكبر، وبذا يستحق جميع العراقيين مكافآت السجناء السياسيين عوضاً عن البترودولار.

ليفانت – سعد الساعدي
العلامات
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!