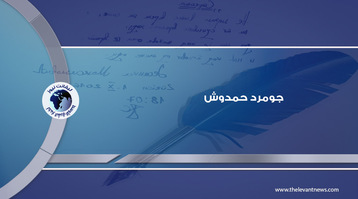-
نوبة هلعي الأولى

شاهدت اليوم تقريراً عن شابة وشاب تزوجا في لبنان، أمر طبيعي يحدث كل يوم لكنه يحتلّ أهمية خاصة حين تكون الفتاة أثيوبية والشاب لبنانياً، تجاوز هذان الشابان الصعوبات القانونية بالزواج في قبرص، لكنهما لم ينجحا في تجاوز العنصرية المتجذرة في لبنان، فاتخذا قرار الهجرة إلى إثيوبيا، كعادة بلادنا تطرد أي مظهر من مظاهر الحب وتفتح ذراعيها للكراهية.
هذه التدوينة محاولة للتحدث عن حادثة لا أنفكّ أتذكرها في المنفى، ذكرى ليست فقط حية إنما أشعر أحياناً أنها كائن حي بذاتها، لاحقتني حتى صارت واقعي وكففت عن تذكرها.
"كانت الدنيا برد"، هكذا يمكن أن أفتتح السرد عن هذه الفتاة، كنا قد حضرنا لها فراشاً في صالون منزلنا، وصندوق نودلز حسب ما أملته الصورة النمطية وبيجاما وفرشاة أسنان لا أكثر، لم نكن نعرف كم ستطول زيارتها لنا ولم نكن متحمسين كثيراً لهذه الزيارة.
كانت شاحبة كثيراً ولم أحتج للحواس التي سقطت مني في رحلة الوقوف على ساقين لأشتمّ خوفها واضحاً، تائهة في معطف شتوي بأقبح درجة من البني مطرز بأحرف ذهبية عند القلب، تحمل حقيبة صغيرة وأجمل شعر رأيته في حياتي.
كنت مع أمي وأختي في المنزل، رسمنا أعرض ابتساماتنا على وجوهنا كجواكر واتجهنا لتحيتها، لم تتحدث ولم تطق أن يلمسها أحدنا، سألتها أمي بالإنكليزية عما إذا كانت جائعة أو ترغب بكأس من الماء، كل ما استطاعت قوله shower shower، ولا أذكر عدد الدقائق التي مرت قبل أن تزرقّ شفتا الفتاة وتبدأ بالارتجاف والتقلص، وتسقط على الأرض أخيراً كلوح من جليد أصفر.
لليوم أشعر بالإهانة من استئذان أمي لي بينما نسندها باتجاه غرف النوم، "معلش ننيمها بتختك؟" تسأل أمي، ما هذا السؤال الغريب بينما نسعف فتاة غريبة مذعورة؟ بالطبع نضعها في سريري وسأعرف لاحقاً أن على الأمر أن يكون مستهجناً في العرف العام.
لم أكن قد شاهدت نوبة ذعر في أعوامي الستة عشر، لم أعرف اسماً لهذه الحالة لكنني سرعان ما عرفت نظرة المحيط لها، والآن بعد عشرة أعوام ما زالت النظرة ذاتها تلاحقني كلما هزتني نوبة ذعر.
اتصلنا بمكتب استقدام العاملات الأجنبيات الذي جاءت عن طريقه ترانزيت إلى منزلنا قبل أن تتابع رحلتها إلى منزل معارفنا، قلنا تكاد الفتاة تموت بين يدينا، وعند الوصف أخبرنا بألا نقلق من هذه "التمثيلية"، وأن الفتاة ليست مصابة بالصرع، وأبلغنا سعادته بالمجيء لأخذها وتأديبها أو استبدالها إذا أردنا! ولمن لا يعرف معنى التأديب هنا فهو يبدأ بالشتم والتعنيف، مروراً بالضرب، وليس انتهاءً بالتحرش والاغتصاب والإذلال الجنسي، ويصل أحياناً إلى القتل والدفن في حديقة المكتب.
هل من داع لأذكر أننا كدنا نصاب بنوبة هلع من اقتراحه؟ وأننا اخترنا أن نتولى الأمر بمفردنا؟
أكاد أشعر بالصمت الثقيل الذي ساد الغرفة بينما جلسنا نشاهدها بحذر، نائمة أسفل الغطاء الشتوي، تكزّ على أسنانها وتنهج كأنها في كابوس لا منته، ياقة الكنزة مبللة بالعرق وبقايا الماء الذي مسحنا وجهها به، ركبتاها مضمومتان إلى صدرها، وتشهق من وقت لآخر كرضيعة منسيّة، لو استطعت وضع صورة على مصطلح ذعر لكانت هذه الصورة بالتحديد.
من هذه الفتاة إذاً، سأعرف حين تطول زيارتها أنها الفتاة التي تستخدم كرت الهاتف لتتصل بحبيبها وليس بعائلتها، وأن عقوبة الحب في عائلتها الأندونيسية النفي إلى بلد عربي لتعمل كخادمة بدل البدء بسنتها الجامعية الثانية، وسأعرف أنها ترسم على دفترها قلوباً وورود حول اسمه والرسائل التي تكتبها له وأشتهي قراءتها.
لاحقاً أصبحت صديقتنا، في انتظار تأشيرة السفر تذهب معنا لمشاهدة شجرة الميلاد في منزل صديقات طفولة أمي، وتأخذ العملة النقدية من جدي مثلنا، وتأكل المكدوس صباحاً كسورية أصيلة. لكنها مرت بكل ما يمرّ به الوافد حديثاً من مآسٍ، والأسوأ أنها احتاجت لتمرّ به مرتين.
نهاية فصل الفتاة مؤقتاً.
يعرف من يعرفني أنني لاجئة في فرنسا منذ ثلاثة أعوام، وصلت كهذه الفتاة لا أعرف أحداً، لأحتلّ موقعي سريعاً في أسفل الهرم الاجتماعي، موقعي المبطّن بكلّ التصورات والأحكام المسبقة، دون لسان فرنسي لأرد أنا الثرثارة التي تملك لساناً طويلاً إكلينيكاً بشهادة طبيب، بالطبع لم أحتج للغة لأعرف موقعي، كان هذا معروفاً وواضحاً.
قبل صعودي إلى الطائرة تعلمت كيفية قول "أنا تائهة" بالفرنسية على سبيل الدعابة، وحين نزلت من الطائرة لم يكن الواقع مضحكاً بقدرها، لا يمكن وصف شعور التيه في مكان لا تتحدث لغته ولا تملك فيه هاتفاً أو رقماً للاتصال به، لديك شكل غريب وملابس تميزك عن القطيع حولك، وحياتك على قيد انتظار ورقة مصير. حسناً يمكن وصف الشعور لكنه لن يتسع هنا.
لطالما أفكر بالعاملات الأجنبيات في حلب، كنت في الابتدائية حين بدأ الناس في حلب باستقدام العاملات، قررنا أنا وأختي بعد عدة سنوات، كنت في الإعدادية على ما أذكر، مطالبة والديّ بهذا الحق الذي حصل عليه زملاؤنا في المدرسة، وجاء رد أبي قاطعاً وحاسماً: لن نساهم في هذه العبودية!
لكن أبي إنها تعمل براتب! كانت هذه حجتنا التي أشعر اليوم بمدى سخافتها، هؤلاء الفتيات كنّ يتقاضين 166 ليرة باليوم، ما يعادل سندويشتي شاورما مع بيبسي، خمسة آلاف ليرة شهرياً، لا يوم عطلة بالطبع، لا ساعات عمل محددة، لا معاملة آدمية في المكاتب، لا ضمانات ولا حقوق في المنازل، وكان شائعاً أن يشترك منزلان على عاملة واحدة، أو تعيرها ربة المنزل لمعارفها كمكنسة كهرباء لا تتعب ولا تُستهلك، وها نحن نحاجج أبي براتبها.
في كل مرة قال لي أحدهم لديّ صديق لاجئ، أو لديّ صديق سوري، وافترض أننا سنملك الصفات ذاتها أو سنكون أصدقاء بالفطرة أذكر ما فعلناه مع هذه الفتاة، في اليوم التالي لوصولها ذهبنا إلى المول، لفت نظرنا أن الفتاة لا تستغرب أدراج الكهرباء ولديها ذوق جيد وعصري في الملابس، كما يعلّق الفرنسيون على بديهيات الأمور، فعلاً "الكعكة بيد الفقير عجبة" كما يقولون، المهم، يومها وحين رأينا عاملة آسيوية في الكافيه التي جلسنا فيها استأذنا مرافقيها بأن تتحدث إليها وتشرح لها أنها ضيفة لدينا وليس لديها شيء تخاف منه في بيتنا، لاحظوا أن هذا قبل زمن مترجم جوجل، ولاحظوا أننا استأذنا المرافقين وليس الفتاة وأننا افترضنا تحدّث الفتاتين اللغة ذاتها، وافترضنا أيضاً أن عبارة "ليس لديك شيء لتخافي منه في منزلنا" كافية لنزع الذعر من صدر الفتاة، لو أننا كنا نعرف فقط ما تفعله البلاهة رغم كل حسن النية فيها.
وبالطبع عليّ أن أتذكر نديرة حين أتذكرها، لا يتسع المجال أيضاً لوصف "كاراكتير" نديرة، لكنها كانت باختصار شابة ظريفة، تضحك كثيراً رغم ثلاثة طلاقات خلّفت ثلاثة فتيات في ثلاثة منازل مختلفة، تسمع أغاني هاني شاكر بأعلى صوت، ترى الموت وتعود منه كلما جربت وصفة تنحيف جديدة، وتقرأ الفنجان، تأتي إلى منزلنا خمسة أيام في الأسبوع لتنظيفه، وأسرق ساعة يومياً معها عند عودتي من المدرسة قبل الجميع، تعد نديرة القهوة بوجه ونشربها ونضحك على قصصها التي لا تنتهي.
كانت أمي قد شرحت لنديرة أن هذه الفتاة غريبة وحزينة، وأن علينا مساعدتها واحتضانها، لكنّ نديرة فضّلت أن تجلس على الكنبة في الصالون ترفع قدميها على الطاولة وتشرب قهوتها بينما تدعك الضيفة الأرضيات وتعصر المساحات، ولم تنجح كل محاولات أمي ورجاءاتها بالتخفيف من غيرة نديرة وكراهيتها لهذه الوافدة التي تأكل وتشرب وتنام ولا تعمل رغم أنها تأتي بعلامة فارقة تشبه علامة "لاجئ"، علامة "عاملة أجنبية" تجعلها مشاعاً.
عندما أفكر اليوم بسلوك نديرة لا أستغربه، سلوك تقليدي في السلسلة التقليدية التي زجّت بنا الأنظمة القمعية داخلها، القمع القادم من أعلى والذي يمارسه كل فرد على الفرد الذي يعثر عليه بالدرجة الأسفل، ونديرة التي كانت تسكن في غرفة إسمنتية بسقف صفيح مصيرها الهد عند الانتهاء من بناء عمارة يحرسها والدها، والتي تأتي ببقع وكدمات من "شجار" مع إخوتها، ولا تملك حق رؤية بناتها وتبحث دائماً عن عريس لأن هذا هو الحل الوحيد الذي لقنوها إياه، نديرة وجدت الضيفة مناسبة لتجلسها على الدرجة الأسفل، وتستمتع بفنجان القهوة وإذلالها.
أفكر بنديرة كلما تعرضت لعنصرية غير مبررة من مهاجر أو لاجئ أو فرد مسحوق في فرنسا، غير مبررة لكنها مفهومة أقول في نفسي، وأقول ليت الضيفة تتذكرني أنا، تركت في رقبتها عقداً صغيراً بعلاقة على شكل يراعة، نزعته من رقبتي في وداعها على الباب، بكينا وتمنيت في قلبي أن تتذكر بكاءنا على فراقها وتنسى تماماً استهجان الذين جاؤوا لأخذها من استحمامها في حمامنا بالشامبو ذاته الذي نستحم به وتذمرهم من الحاجة "لإعادة تأهيلها"، تمنيت أن تسمح لها حياتها القادمة بنسيان نديرة أو مسامحتها.
واليوم، كحجر أخير في الرابط العجيب للذكرى، أتمنى للثورة في لبنان أن تنجح، تنجح بإعادة التفكير بسؤال حقوق الإنسان، تنجح بتحصيل حقوق العاملات الأجنبيات بالوقوف على الكورنيش في يوم عطلة رسمي أو بعد انتهاء عدد ساعات العمل الرسمية، ولا يكون مشهد زواج لبناني أو لبنانية من أجنبي أو أجنبية "عجبة" فقط لأنه من جنسية يطالها وصم "العامل الأجنبي"، فلا يحذّر باسم يوسف في برنامج لبناني من أن سكتشاً عنصرياً بحق العاملات الأجنبيات قد يسبب مشاكل عند ترجمته، ألا يبدو واثقاً بأن العنصرية لا تعنينا في العالم العربي، وألا ترد عليه الضيفة الأخرى بعبارة قميئة تشبه "لكنهن يقبضن بالدولار".
"لكن أبي إنها تعمل براتب!" هل تنجح ثورة لا تطالب بحقوق الإنسان؟ كل إنسان وليس حقوقنا فقط كمواطنين منقوصي المواطنة؟ نوبة هلعي الأولى
مدونة ليفانت - فرح يوسف نوبة هلعي الأولى نوبة هلعي الأولى نوبة هلعي الأولى نوبة هلعي الأولى
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!