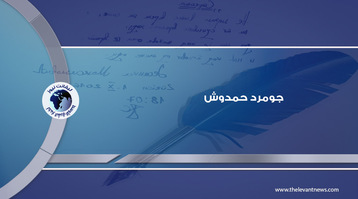-
موتوسيكلي: عن العصيّ في دواليبنا

كنت طفلة صغيرة آتية من حلب، المدينة التي لا يحدث فيها ما يثير الاهتمام، ومن كل ما تملكه بيروت من عجائب بالنسبة لمن هي مثلي، أسرني مشهد الفتيات والشباب على الدراجات النارية، موتسيكل كما أسميه منذ سمعت به للمرة الأولى.
كان والداي يجرّانني بصعوبة من أمام واجهات محلات الموتسيكلات، حيث أتسمّر بثبات الحلم وتتسع حدقتاي وآمالي بينما أراقب الأنواع وأقفز بخيالي من واحد لتاليه، أفكر أن اعتلاء إحدى هذه "المكنات" يقترب كثيراً من الطيران، وأحاول محاكاة شعور الريح وهي تعبث بذيل الحصان المتسلل من الخوذة ذهنيّاً، وأسأل نفسي ما إذا كنت سأجرؤ على إفلات المقودين وترك الموتسيكل يأخذني إلى السماء.
لسببٍ ما، وعدني والداي بإهدائي دراجة ناريّة عند نجاحي في امتحان الثانوية العامة لأذهب بها إلى الجامعة، عشر سنوات كان عدداً مخيفاً من السنين آنذاك، وكنت مستعدة لانتظارها بصبر الأنبياء.
كلما اقتربت من الثامنة عشر ابتعد حلمي، كنت أتيقّن يوماً بعد يوم أنّ الموتسيكل كان مجرّد وعد لإسكات طفلة صغيرة، أو جزرة مربوطة بحبل ليجرّني بحماس إلى مجموع علامات يرضي والديّ، وكنت أتيقّن أن والديّ لن يقفا في وجه المدينة لأجلي، ليفيا بوعديهما ويحققا حلمي.
هذا اليقين كان يؤذيني كل يوم، يؤذيني لأنّه يشعرني بالقفص الذي هو المجتمع، باغترابي واختلافي عن بَلادة الحياة حولي، وبملعقة المجتمع التي تنحشر في حلقي وتجبرني على ابتلاع لزوجته كما كنت أُجبر على ابتلاع محشي الملفوف في طفولتي.
كان هذا اليقين يقتلني، إذ يسخر من وحدتي، الوعد ليس سلاحاً يقول لي، والأهل لا يفون بوعودهم، وحدي كنت بمواجهة الأسر الذي كنت أجهل منطقه ،أسبابه، ما المريع حقاً في امتلاكي موتسيكل؟.
لاحقاً بدأت أفهم المريع في امتلاكي موتسيكل، ليس لأنّ القضية كانت مفتوحة للنقاش، لكن جدلاً خجولاً شبيهاً كان يدور في سوريا، جدل متأخّر عن أوانه، فبينما كانت امرأة باريسية "شجاعة" تركب دراجة مخصّصة للرجال في القرن التاسع عشر، احتجنا في حلب قرنين لنتساءل حول حقّنا في ركوب الدراجة، أو الموتسيكل في حالتي.
في كتاب عجلات التغيير: "كيف ركبت النساء الدراجة إلى الحرية" اقتبست الكاتبة مقالاً نُشر في Munsey's Magazine عام 1896، قولاً ما يزال صالحاً إلى يومنا هذا كنساء الدول النامية على وجه الخصوص، بالنسبة للرجال كانت الدراجة في البداية مجرد لعبة جديدة، آلة أخرى تُضاف إلى القائمة الطويلة من الأجهزة التي يعرفونها في عملهم ولعبهم. بالنسبة للنساء، كانت فرساً ركبوا عليه إلى عالم جديد.
بالطبع لم تنجُ النساء حول العالم من جهود منعهنّ من ركوب الدراجات، وتشير الإحصائيات إلى فجوة جندرية في ركوب الدراجات حول العالم، حتى في الدول الصديقة للدرّاجين بصورة عامة، الأسباب في البداية كانت جنسية كالعادة.
الاهتزازات التي تسببها الدراجة قد تحفّز العضو الأنثوي وقد تقود_لا قدّر الله_ إلى نشوة جنسية للمرأة وقد تقود أيضاً _لا قدّر الله_ إلى تحرّر المرأة جنسياً، المرأة ذاتها التي كانت ممنوعة من ركوب الحصان إلا جانبيّاً لأن خلاف ذلك غريب وغير أنثوي، ناهيك عن أنّ الوجه الجدّي الذي تفرضه قيادة الدراجة قد يُفسد جمال النساء.
استمرّت النساء بفعل ما يفعلنه، المقاومة، بدعم صغير من الذكوريين الذين باركوا الأمر انطلاقاً من اعتقادهم أن قيادة الدراجة تجعل المرأة أمّاً أقوى، ولعبت الدراجة في هذه المرحلة دوراً في التحرر من المشدّات والفساتين والتنورات الطويلة والسميكة وولادة ما يُعرف بلباس الدراجة، ملابس تغطي الجسد كاملاً لكنها أضيق حول الكاحل، فحسب وصف الدرّاجة هيلينا سوانويك: "إنها تجربة غير سارّة أن تُلقى الواحدة على الأرض لتجد أن تنورتها التفّت بإحكام حول الدواسة، لدرجة أنها غير قادرة حتى النهوض وفكّها".
وأصبحت المرأة الدرّاجة ترمز للمرأة النسوية الساعية للتحرر، التي تطالب بحقوقها كاملة، من تدخين سيجارة إلى الانتخاب والتصويت، حتّى إن الصورة أدناه تُظهر دمية لامرأة تركب دراجة متدلية من نافذة، كانت تلك طريقة طلاب جامعة كامبريدج بالاحتجاج على مقترح قبول النساء عام 1897.
أين سقط موتوسيكلي في تاريخ النسوة مع الدراجات إذاً؟ إنه مدفون في مكان ما مع بقية حقوقي التي فقدتها عند ولادتي في سوريا، وبقليل من "النبش" و"البحبشة" يمكنني تعقّب أثره.
هذا الموتسيكل قد لا يتسبب بنشوة جنسية بالضرورة، لا نفكّر كثيراً بنشوة النساء في سوريا، لدينا همّ أكبر، الشرف القابع بين ساقيّ النساء وقيمتها الأسمى، الغشاء الذي إذا نزف بغير اللحظة المثالية لنزفه على يد الزوج فإنه يعني فساد الفتاة وانتهاء صلاحيتها.
الهوس بحماية الغشاء بأيّ ثمن يمنع الفتاة من فرد ساقيها إلا للضرورات، والصدمات المحتملة من ركوب الدراجة مخاطرة لا تدخل ضمن الضرورات في هذه الحالة، حتى ولو أباح الشرع السائد في البلاد ركوبها مثلما أباح نبيّ الإسلام ركوب المواصلات مثل الإبل كقوله: "خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ".
فلا يكفي الفتاة هنا أن تلتزم "الآداب الشرعية" من احتشام في الملبس وحرص عند الصعود والنزول لئلّا تنكشف عوراتها كالكاحل والركبة مثلاً لتحظى بحقّ استخدام الدراجة، بل عليها أن تترك الأمر جملةً وتفصيلاً، فهو على أيّة حال تشبّه بالرجال والأفضل اجتنابه.
الفتاة هنا تجتنب هذه الشبهة وتأخذ رضى المجتمع باستخدام المواصلات العامة، حيث إن باصات النقل الداخلي السورية مساحة آمنة جداً للنساء على كل الأصعدة، لا نتعرّض فيها للتحرّش الصريح بالأيدي والأعضاء التناسلية، ولا نجد أنفسنا غير قادرات على التنفس من الازدحام في الداخل، ولا يستهلك الزحام في الخارج ضعف الوقت الذي نحتاجه للوصول إلى وجهتنا، هل هناك داعٍ لأشير إلى السخرية القاتمة جداً هنا؟.
والمرأة بالطبع مسؤولة عن بهيمية الرجل غير القادر على كبح غرائزه، الذي تثيره أي أنثى وإن كانت أنثى الفيل، إنها المسؤولة عن حمايته من فتنتها، فكلّ حركة تقوم بها هي بالطبع استهداف مباشر لتستوسترونه وعليها تحمّل أي عواقب لاحقة لفعلتها، بدءاً من الاستهزاء والتنمر وصولاً إلى التحرش والاغتصاب.
ركوب الدراجة بالطبع يندرج تحت لائحة الأفعال المشينة الواجب على الفتاة تحاشيها في سوريا، حتى إن لم يكن المنع بفتوى صريحة تُعرّض مرتكبتها إلى السجن مثلما حصل في إيران، ورغم أن المنطق السليم لا يُشجع الرجال ولا النساء على ركوب الدراجات في سوريا، حيث إن أفضل سيارات الدفع الرباعي قد لا تصمد أمام الطرقات هناك، وحيث إن إنقاذ البيئة يبدو مطلباً عبثياً، لكنّ الاصطدام بهذا التمييز والواقع الذي تتعايش معه النساء في عمري آنذاك كان تجربةً قاسية ما زلت أحاول التعافي منها.
أسير بثبات نحو موتوسيكلي بكلّ ما يُمثّله بالنسبة لي، بمالي الخاص وبعقبات تتناقص مع الأيام، هذه المرة لا أسير وحدي، ولا أشعر أنني وحدي، إننا جيش من النسويات والنسويين مستمرّون رغم المطبّات على الطريق وكلّ العصي في عجلاتنا.
ليفانت - فرح يوسف
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!