-
من درعا.. إلى أفغانستان
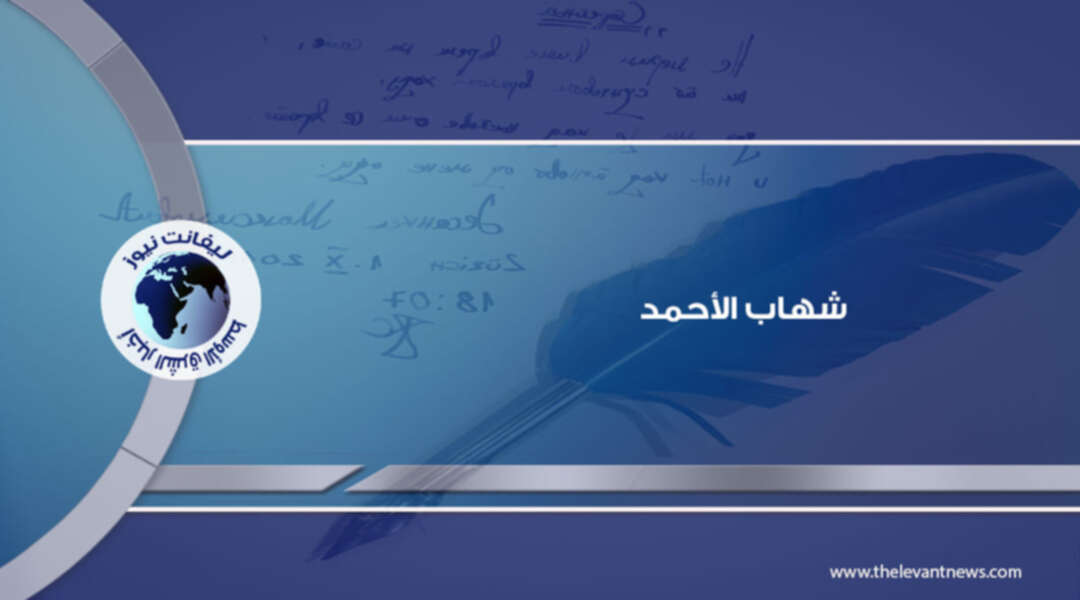
درعا البلد، ومسجدها العمري، الذي انطلقت منه الشرارة التي أشعلت لهيب "الثورة" السورية في منتصف آذار 2011. درعا، الرمز الأيقوني "للثورة" السورية، التي تعاني حصاراً، لو بإمكان النظام الاستبدادي أن يمنع الهواء من الوصول للمحاصرين لفعل ذلك.
وأمام الإصرار المتعنّد للنظام الاستبدادي، على إخضاع درعا، ليس لما تمثله من رمز لكسر كبريائه، والوقوف في وجه عنجهيته وهمجيته، واستمراريتها فقط، بل لاسترداد هيبته، أمام ذاته المتضخمة، التي شرخها ثلة من الأطفال، اللذين لم تتجاوز أعمارهم الخمسة عشر عاماً. يضاف لها، استعادة الثقة لدى القوى الفاعلة الإقليمية والدولية، وعلى رأسها إسرائيل، إقليمياً، والولايات المتحدة الأمريكية، دولياً، لما تمثّله الأخيرة كقطب أوحد على الساحة العالمية، مستنداً في سبيل تحقيق ذلك على القوتين الإقليمية، إيران، والدولية، روسيا، وبغض النظر عما يدفعه من ثمن، عبر ارتهان الجغرافيا السورية وبما تحويه من ثروات وتقسيمها بين القوتين.
هنا تكمن خطورة تلك الخطوات، والثمن الذي يقدّمه النظام الاستبدادي لداعميه، فجلّ الثروات الطبيعية والمرافئ وقنوات الاتصال الإقليمي والمحلي، ستكون رهناً لتلك القوتين، تمتد لعقود من الزمن، وبالتالي ستحرم منها تلك الأجيال القادمة من القاع الاجتماعي السوري، وتعزّ عليه، وهي حقّه الطبيعي الذي أجمعت عليه مجمل القوانين الدولية المتوافق عليها، وشرعة حقوق الإنسان. وبالتالي فتوجهه بالضرورة كان نحو استنزاف كامل طاقات القاع الاجتماعي، وتعريته حتى من ورقة التوت الأخيرة، لقمة العيش (كسرة الخبز) ولو اضطر سيسحبها من فمه، ليشبع نهمه الذي لن يُروى. وحتى يضمن ذلك كان لا بدّ له من إطلاق أذرعه المافياوية، لتعيث فساداً في الطبيعة والأرض والإنسان، وهو ما تجلّى في عمليات حرق المحاصيل والأراضي الزراعية والغابات، والحواجز لتشليح البشر وفرض الإتاوات عليهم، وتعفيش أرزاق الناس سواء المهجرين قسراً، وبطرق شتى، أو عبر المصادرة، وزيادة الرسوم الضرائب، والمتاجرة بسبل العيش، والتي طالت حتى المعونات التي تأتي من شتّى أنحاء العالم، سواء العينية أو النقدية منها. إضافة إلى سرطنة السوق السوداء، وتشعبها كأذرع الإخطبوط، واحتكار كل ذراع منها لأحد أمراء الحرب المحيطين به، والمشمولين برعايته، وما تعيينه "انتخاب" في ما يسمى "مجلس الشعب" لـ"69" فرداً منهم يمثلون معظم المحافظات السورية، وبالتالي اكتسابهم للحصانة "الدستورية"، سوى عنوان لمسيرة السنوات "السبع" القادمة. ذلك "السبع" الذي حول سوريا لغابة، وصدّق بأنه ملكها.
روسيا وأمريكا
وكما القاع الاجتماعي الدرعاوي المقاوم بين سندان القوى الفاعلة الإقليمية من إيران وإسرائيل وتركيا، والدولية من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. كذلك روسيا تعاني من ثبات موقف أهالي درعا البلد، الناتج عن الخبرات المتراكمة للصراع الدائر في سوريا عامةً، ودرعا خاصةً، وتعنّت النظام "الأسدي" والإيراني، بالدرجة الثانية، ويطفو عليه الأمريكي والإسرائيلي بالدرجة الأولى، ويليه التركي.
بدايةً تجلّى التدخل العسكري الروسي، في "الحرب السورية"، بشكل أساسي في إمداد الجيش السوري بالسلاح، وما تدخلها العسكري المباشر، الذي بدأ بتاريخ 30 أيلول/ سبتمبر 2015، إلا بعد طلب رسمي مباشر من النظام السوري لمساعدته عسكرياً في حربه ضد ما سماهم من كافة فصائل وألوان، حاملي السلاح ضده، سواء المدافعين عن النفس أو فصائل الجيش الحر، أو الفصائل الأخرى "الإرهابيين" في سوريا، وذلك تحت الضغط العنيف لتلك المجموعات المسلحة، وتوسع رقع انتشارها وسيطرتها، لما يقارب ثلثي مساحة سوريا الجغرافية، وباتت حتى القرى الأكثر تماهياً مع النظام، في اللاذقية، والتي يعتبرها حصنه الحصين، ومن ضمنها القرداحة، مسقط رأسه، تحت مرمى نيرانهم.
وعقب ذلك، بتاريخ 11تشرين الأول/ أكتوبر، صرّح الرئيس الروسي بوتين بأن الهدف الروسي من التدخل العسكري في سوريا، يتمثل في تحقيق الاستقرار للسلطة "الشرعية" سعياً وراء تسوية سياسية.
وكما استقطب التدخل الروسي دعم العديد من الدول إلى جانبه، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، إلا أنه تم مواجهته برفض واستنكار من غالبية القوى الفاعلة في المجتمع الدولي، واتهامهما بالتواطؤ مع النظام السوري بالجرائم التي تصنف تحت مسمى "الحرب" و"ضد الإنسانية".
مقابل هذا الدور العسكري المباشر لروسيا، تجلى الدور السياسي الأكثر تأثيراً ونجاعة، في دعمه للنظام الحاكم في سوريا، وتعويمه، وذلك في العديد من اتفاقيات "المصالحة" و"وقف التصعيد"، إضافة إلى خلق مسارات للتسوية السياسية تكون بديلة عن "جنيف" والقرار 2254، الأمميين. كمساري أستانا وسوتشي.
في 7أيار/ مايو 2017، وعلى وقع تداعيات الصراع المسلح في الجنوب السوري، وبالأخص على إسرائيل، عقدت كل من روسيا (بديلاً عن النظام)، والولايات المتحدة الأمريكية والأردن (بديلاً عن المعارضة المسلحة)، اتفاقاً لوقف إطلاق النار، ومن ثم في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، طُور إلى اتفاق خفض التصعيد برعاية الأطراف ذاتها، محتوياً بالآن ذاته المحافظات السورية الثلاث في الجنوب، وهي السويداء ودرعا والقنيطرة. كما أتى على أرضية تعديل عمل غرفة العمليات المشتركة "موك" (Military Operations Center)، تلك الغرفة التي تشكلت في عام 2013، بقيادة أمريكية ودول أوروبية وخليجية، وضمت فصائل مسلحة عديدة في درعا والقنيطرة وريفي دمشق وحلب الشمالي.
وكان على رأس الأهداف للغرفة حماية الأمن والحدود الإسرائيليين، إضافة إلى التزام الفصائل المسلحة بكل ما يصدر عن غرفة العمليات، بما يتعلق بالعمليات العسكرية، تلك الأوامر التي كان لها دور أساسي في عدم سقوط العاصمة دمشق، وحصر وتحجيم المواجهات العسكرية مع النظام.
وعلى وقع الاتفاق الجديد، وتوقف الدعم العسكري والمادي للفصائل، وإعادة ترتيبها، أتى إعلان وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر، في تموز/ يوليو 2018، بفتح جبهة جديدة في الجنوب ضد الفصائل المبايعة لتنظيم "داعش" في ريف محافظة درعا الغربي.
وبين الحراك الدبلوماسي الروسي الأمريكي، وعلى أرضية الأمن الاستراتيجي الإسرائيلي، بعدم التعرض لقوات النظام، وتمكينها من الوصول إلى الحدود الأردنية وحدود الجولان، يتضح مؤشر مهم حول أفضلية تعويم النظام، على غيره من البدائل.
يوضح جو بايدن بخطابه للشعب الأمريكي، حول "الانسحاب" الأمريكي من أفغانستان بأنه "ليست مهمتنا هناك بناء دولة، أو خلق ديمقراطية موحدة ومركزية".. وذلك بعد عشرين عاماً من الاحتلال الأمريكي لأفغانستان.
سوريا أرضاً وشعباً إلى أين؟
ليفانت - شهاب الأحمد
العلامات
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!





















