-
ظلال سوريّة للموت
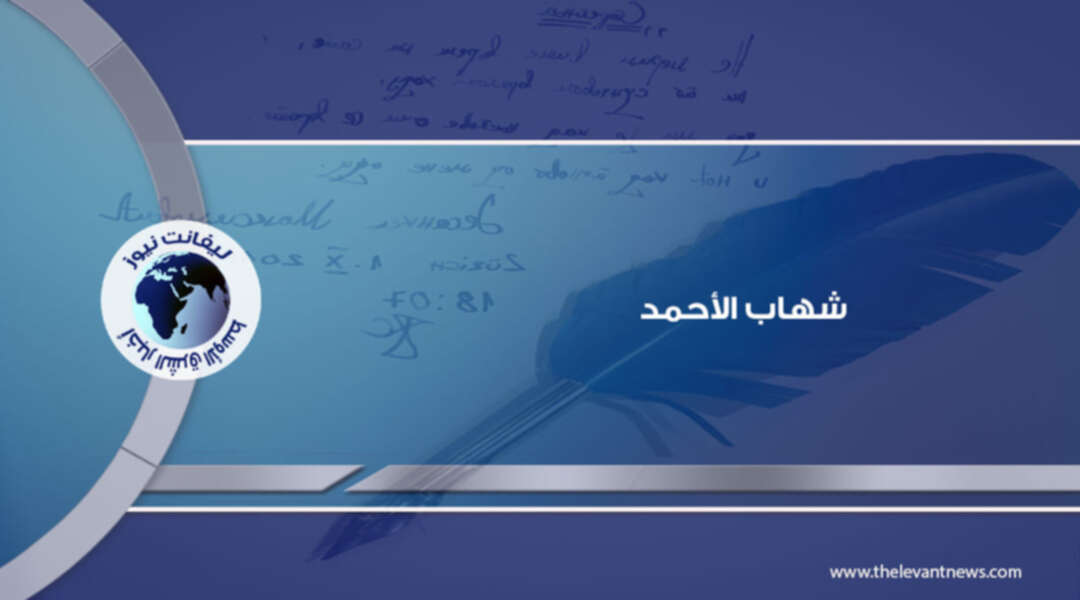
يرى الدكتور إمام عبد الفتاح إمام في مقدمته لكتاب "الموت في الفكر الغربي" بأن "الموت يتبع مع الجميع سياسة ديمقراطية تقوم على المساواة المطلقة"، وهذا نابع من الطبيعة الكلية المطلقة للموت، ولكنه بالآن نفسه يحمل "طابع الشخصية الجزئية المطلق، لأن الموت فردي وشخصي وخاص".
ويرى بأن الارتباط ما بين الموت والحرية، كما يقال ما هو إلا نتاج الخطيئة الأولى، التي أتت على أرضية الممارسة الحرة للمرة الأولى للإنسان.
ما بين الكلي المطلق، والجزئي المطلق للموت، تفردت المحرقة السورية بُعَيد اندلاعها في 2011، بإلباسه رداءً رثًّاً وعتيقاً، يعود لقرون من الجمود، والمصادرة أو الحجر على حرية الفكر الإنساني، من خلال التمييز ما بين موت وموت، ليس على أساس الطريقة والأداة والشكل، أو الهدف والغاية التي مات فيها إنسان ما، وإنما انتماؤه لعقيدة محددة، أو لموقعه بين طرفي الصراع.
موت فطيس.. وخطف
في تجربة الموت السوري -كمعبر للحرية ورفضاً لدكتاتورية متوحشة- ما زال خلال عقد من الزمن يخضع لتهويمات وصفية ما بين "شهيد" و"فطيس" وخطف وإخفاء قسري. لا فرق بين طفل ورضيع، وبين أنثى وذكر، وبين مدافع عن الحرية الإنسانية ومدافع عن نظام متوحش، استباح الإنسانية في سبيل كرسي، وتنفيذاً لدور ومهمة أوكِل بأدائها، أو الخارج من كهوف العصور الوسطى، يسعى لإعادة إحيائه عبر جعل الحاضر وقوداً لذلك التاريخ.
وكأن الخطف، أو الإخفاء القسري، لعبد العزيز الخير، وللعديد من المناضلات والمناضلين، في سبيل الحرية، ورحيل "ميشيل كيلو"، أعاد إشكالية الموت ليتصدّر المشهد السوري، فكرياً وأخلاقياً، على مستويي القاع الاجتماعي، بكل أطيافه، والنخب السياسية، بكل تلاوينها. وطفا (حينها، ويطفو بأشكال عديدة) على السطح، كمستنقع عفن، يعكس على سطحه، العطن السياسي والتاريخي والأخلاقي، الذي تردّى إليه الواقع السوري. نتيجة للعنف المتوحش، وبصوره الثلاث: القتل، والتعذيب، والإرهاب بأشكالٍ شتّى، من الخطف والإخفاء القسري، إلى التجويع، الذي مُورس على المجتمع، وزاده زخماً طرفي المعادلة، عنف النظام والعنف الآخر، بما تناقلته أقلام من مشارب وخنادق ومتارس مختلفة ومتعددة: "هل يجوز الرحمة على ميشيل؟"، وهل إحياء لذكرى خطف عبد العزيز الخير، ما ينكئ سيرورة الجرح السوري النازف، عبر ما يزيد عن العشرة أعوام، وسيستمر.. ما دامت تلك متسيدة على المشهد السوري. وكأن ما تبقى من أشلاء المجتمع المتشظي، قابل أن يُشرذم أكثر فأكثر.
لم يطلب ميشيل الرحمة، ولم يستجدها بموته في المنافي، عايش الموت، وعاصره في كل لحظة من نشاطه المعارض، كما يعايش السوريون استبداد النظام في عهد "الأسد الابن"، كما عايشوا ظلام العهود الماضية، بالتهميش والاستبعاد والتغريب، إضافة للموت جوعاً وقهراً وإذلالاً، كما لم يساوم عبد العزيز الخير، في نضاله ضد نظام طغى، بهدف "إسقاطه بكل رموزه ومرتكزاته".
"سامحيني يا خالة، والله ما كنت بعرف"، الجملة التي توجه بها (منشق عن جيش النظام) نحو الروائية سمر يزبك، ويتابع: "أنا ما بكره حدا، بس هن كلاب بدهون يانا نقتل الناس.."، وقبل متابعة المسير تتوجه له: "لكنني لست علوية، وأنت لست سنيّاً. أنا سورية، وأنت سوري".
لم تميز آلة الموت السلطوية بين ضحية وأخرى، كل السوريين أعداء، ما لم يثبتوا العكس، ويقدموا فروض الطاعة والغفران، وإثبات الولاء لقاهري "نعمتهم"، لا فرق بين سوري وسوري، لا باللون ولا بالجنس ولا بالدين ولا بالقومية، وحتى الطائفة والعشيرة، ليستا بمنجى من الموت، إن خرجت عن قطيع النظام، وفي الخندق الآخر إن رفضت الراية السوداء، ورفضت كهفها التاريخي.
جسد ذلك الشاب اليافع (المنشق) عن الوحدات الخاصة، في رواية بوابات أرض العدم، للروائية سمر يزبك، برفضه قتل الناس، ونشدانه للحياة، عفوية الانفجار السوري الكبير. ولكن أن ينحى ذلك الانفجار بعد عشر سنوات من القتل والتهجير والدمار إلى الوقوف أمام الموتى، ليرى هل تجوز الرحمة عليهم؟ وهل هذا الموت فطيس، أم شهيد وأمام الخطف والإخفاء القسري، هل من جدوى، إن لم نقل هل "الواقعة" تستحق النضال لأجلها؟
لقد تجلى الموت السوري، بملايين الأوجه والأشكال، التي طالت مختلف أشكال الحياة السورية. التحق به، وتفتق عنه عشرات ومئات البوابات للفردوس المنشود "المفقود"، فمن "الهياكل التقليدية" عشرات، بل مئات المنصات، والمجموعات والجماعات والمؤسسات، والتي استصرخت بعدالة القضية السورية والشعب السوري، ونصرته، وإسعافه ومساعدته، ولم شتاته الممزق، ولكنها وبالحد الأدنى لم تستطع، توحيد جهودها، في سبيل هذا الشعب المنكوب.
سلاح النظام
يستهل برهان غليون كتابه "عطب الذات بـ"خطفتني الثورة السورية كما خطفت معظم السوريين"، حيث سعى فيه لإلقاء شعاع من الضوء على حدث استثنائي في تاريخ المنطقة. يُبرز من خلاله المزالق، التي أدّت بقيادات المعارضة السياسية ومؤسساتها، لترسيخ ما عمل النظام السوري عليه، من عسكرة الحراك المدني، إلى تطييف الشارع وشرذمته. وأدّى لانجرار الشارع وراء شعارات تمزق النسيج السوري، وتبرز هشاشته أمام آلة القمع السلطوية، وهيمنة للعقلية الإقصائية، المستندة لتجارب وخبرات، ولأعراف وتقاليد وفتاوى، غيبت الهدف الأساس للحراك الشعبي في استرجاع حريته المسلوبة، وكرامته المهدورة منذ عقود. ذلك الماضي القريب، الذي أجبر الطفل "جمعة الدشاش" في رواية "النباشون" لـ"سوسن جميل حسن"، التعرف على جميع الحاويات، مواقعها ومحتوياتها، في سبيل لقمة عيش الذّل. لا فرق بين حاوية وحاوية، سوى بمحتوياتها، التي يتميز بها من وُضعت لخدمتهم في رمي نفاياتهم بها، من أنماط معيشية تتراوح ما بين العوز والترف، وكان مريدو تلك الحاويات من المعدمين.
فالحاويات لم تفرق بين مريد ومريد، هي لكل المعدمين والمقهورين، من يأتي أولاً ينال منها حصة "الأسد". لم تبق الحاوية مجرد مكب لنفايات، وإنما تحولت واتسعت وتضخمت، لتشمل حياة جلّ القاع الاجتماعي السوري، وأصبح "جمعة" وحماره "أبو طافش" رمزاً لذلك القاع، ورمزاً للموت المعلق، الذي سحقه، وسلبه النظام في عهد "الأسد الأب" حريته الإنسانيّة.
كما ركز القاع الاجتماعي، على تصنيف الموت السوري بين حدين، لا ثالث لهما، ما بين "فطيس" و"شهيد". تكرّس أداء المعارضة السورية بشكل عام، ما رسّخه النظام منذ عقود.
ليفانت - شهاب الأحمد
العلامات
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!





















