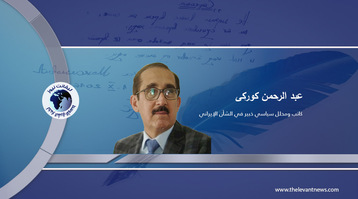-
الخطاب السياسي بين الشعبوي والمتعالي

طيلة عقود ثلاثة من حكم حافظ الأسد واحتكار نظامه الاستبدادي للسياسة والشؤون العامة جميعها بصورة مطلقة، اقتصر الاهتمام بالشأن السياسي على دوائر ضيقة ومحدودة من السياسيين والمثقفين، لاسيما المنتمين إلى أحزاب المعارضة المحظورة، أو المستقلين المقربين من أوساطها.
بعد موت الأسد الأب وتوريث السلطة لابنه بشار سنة 2000، حصل انفراج نسبي للقبضة الأمنية، بالتزامن مع وصول طلائع "ثورة الاتصالات" إلى سوريا. هذه المعطيات المستجدّة، وفّرت هامشاً أوسع نوعاً ما للكتابة السياسية، سواء في الصحافة اللبنانية، أو في عدد من المواقع الإلكترونية، وبرز عدد من الكتّاب، سبق لبعضهم أن قضوا سنوات مديدة في سجون النظام. ثم جاء التحوّل الأهمّ في تاريخ سوريا المعاصر، باندلاع الثورة السورية في آذار (مارس) 2011، فعادت السياسة وشؤونها لتطغى على ما عداها من اهتمامات قطاعات واسعة من السوريين، مؤيدين ومعارضين ورماديين.
بعد الثورة، اتّسعت دوائر المشتغلين في إنتاج "الخطاب السياسي" في مختلف وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، لتشمل أعداداً متزايدة من المثقفين، رجالاً ونساءً، كتاباً وصحفيين وأكاديميين، وحتى شعراء وأدباء، عبّروا عن آرائهم في ما يجري، وساهموا، بدرجات متفاوتة، في "صناعة الرأي العام" ومواكبة الحدث السوري العظيم.
من جملة ما برزَ خلال السنوات العشر الماضية من أساليب الخطاب السياسي، يمكن تمييز شكلين متكاملين في ضررهما، رغم ما يبدوان عليه من اختلاف ظاهر، وهما: الشعبوي، والمتعالي.
يستمدّ الخطاب الشعبوي عناصره من ظاهرة الشعبوية نفسها، بما فيها من ميل إلى التبسيط والاختزال وإطلاق الشعارات الكبرى، فضلاً عن الرغبوية والنزعات التبريرية، ويزعم معالجة مشاكل مركّبة وحقيقية، بتقديم وصفات بسيطة زائفة للجمهور. والغرض هو استمالة فئات محدّدة، وحشدها حول أصحاب الخطاب الشعبوي الذين لا يكفّون عن بيع الأوهام. والخطاب الشعبوي لا يقتصر على أيديولوجيات أو تيارات سياسية بعينها، وإنما هو من المشكلات التي تعتور العمل السياسي في العديد من الدول والمجتمعات في العالم. يمكن اختصاره بأنّه أسلوب تعبوي انتهازي، يعتمد على استثارة الغرائز والعواطف، واستنفار كل ما هو لاعقلاني لدى المتلقّي، بما يساعد الشعبويين على جذب الجمهور وتحقيق مكاسب سياسية على حسابه. فهو خطاب يحوّر الحقائق ويلوي عنق الواقع ليُسمع "الجماهير" كلاماً يطربها ويرضيها، بعيداً عن حقيقة الأحوال أو ما آلت إليه على أرض الواقع.
في المقابل، ظهر ضربُ من الخطاب السياسي المتعالي، المتخم بمصطلحات ومفاهيم يرطن بها أصحابه، في نصوص بليدة متغطرسة، أقرب إلى ثرثرة لا تقول شيئاً. هذاالنوع من الخطاب يمتاز بانفصاله عن الواقع وتعاليه عليه، رغم زعم أصحابه مقاربة القضايا بصورة "علمية" رصينة. لعلّ مبعث الانفصال هنا، أنّ منتجي هكذا خطابٍ متعالٍ، هم أسرى مناهج "مدرسيّة" وترسيمات وقوالب "أكاديمية" مصطنعة، مما أفقدهم حساسية التقاط الواقع الملموس، فضلاً عن إمكانية الحديث عنه بمفردات يمكن للناس فهمها، عوض التحليق في سماء التنظير المتعالي، والمستغلق على أفهام جمهور يعده بهرج المفردات الطنّانة، فينسب لأصحابها "فهماً عميقاً" هم أبعد الناس عنه.
لغة الخطاب المتكلّفة، المصطنعة، والغامضة هذه، تحقق لصاحبها غايتين، أولهما إظهار نفسه كـ"مثقّف" ذي شأن، والثانية، وهي الأهم،التحايل على المتلقّين، من القرّاء أو المستمعين أو المشاهدين، خصوصاً إن كانوا من غير المختصّين، بطريقة تجعل من الصعب عليهم تبيّن حقيقة أنّ هذا الغموض والحشو "المفاهيمي"، ليس سوى "عدّة شغل"، للتمويه على تفاهة المحتوى، وخلوّه من أي فائدة أو قيمة في الموضوع المعني. وبمثل ما ينتفخ الخطاب الشعبوي بالشعارات والعواطف الجاهزة، كذلك يفعل الخطاب المتعالي بتراكيب ومصطلحات جاهزة، مع فارق "بساطة" الأول و"تعقيد"الثاني.
في الحالتين، يتعمّد أصحاب كلّ من الخطابين تجاهل الظواهر والمعطيات الصلبة، والوقائع العيانية التي لا تفعل ادّعاءاتهما سوى إخفاءها وتضليل رأي الجمهور بشأنها، فهي تكشف زيف الخطاب الذي ينتجانه وخواءه. ذلك أنّ التحليق في عوالم الشعارات والعواطف الجياشة، أو المصطلحات والمفاهيم البرّاقة شيء، ووعي الواقع ومعطياته الملموسة والتعامل مع المشكلات العيانية، تحليلاً وفهماً وبحثاً عن حلول لها، شيء آخر تماماً.
إنّ ما يملكه "المثقفون" والمشتغلون في صناعة الرأي من أدوات تساعدهم في التعبير عن الأفكار، وتمدّهم بالقدرة على إقناع الآخرين والتأثير فيهم، ينبغي ألا يكون "ميزة" تمنحهم تفوّقاً يرضي ذواتهم ويوفّر لهم عملاً فحسب، وإنما يجدر بهم النظر إليه بوصفه أمانة ومسؤولية، لا يجوز إساءة استخدامها في التضليل والخداع. دون هذه المسؤولية سيكونون أقرب إلى "مثقفين مرتزقة"، وفق تعبير المفكّر الفرنسي (باسكال يونيفاس)، الذي وصف هؤلاء بأنّهم "لا يؤمنون بشيء، سوى أنفسهم. ينتسبون -أو بالأحرى يتظاهرون بالانتساب- إلى قضايا، ليس لقناعتهم بصحتها، بل لأنّها في تقديرهم واعدة ولها مردود هام وتسير في اتجاه الريح السائدة".

ليفانت - طارق عزيزة
العلامات
قد تحب أيضا
كاريكاتير
من وحي الساحات في سوريا
- December 19, 2024

من وحي الساحات في سوريا
ليفانت-خاص
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!