-
أنا المرشحة 53 لرئاسة سوريا
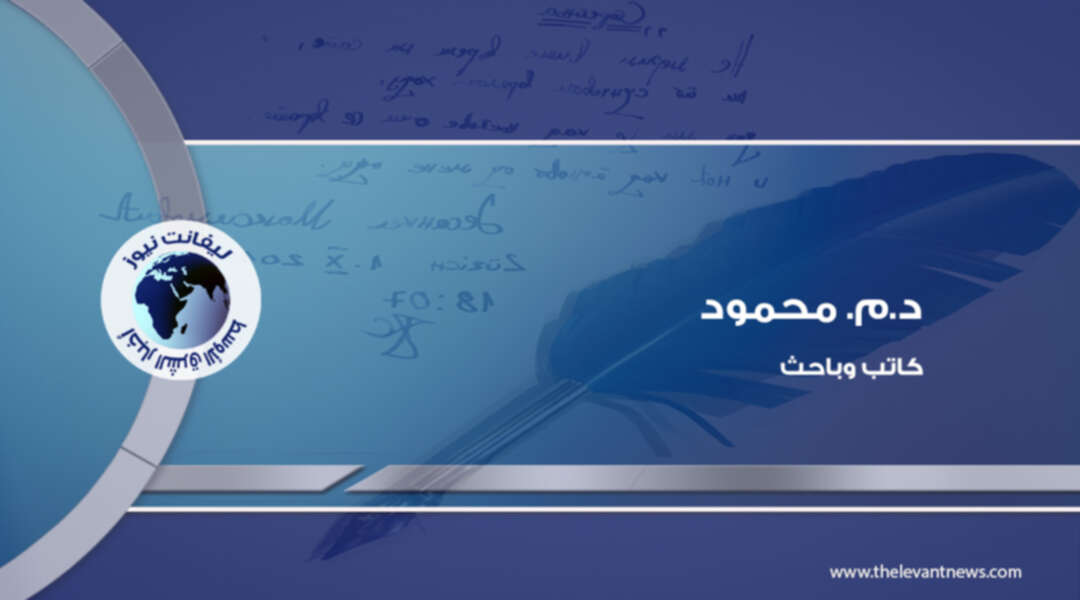
أهذا التعدّد في أرقام المرشّحين هو أحد أوجه تغييرٍ أحدثته ثورة شعبٍ في وجه نظام قمعٍ عتيق أم أنّها واجهةٌ جديدة يُصدّرها هذا النظام ليرسم خارطة الحلفاء الجدد؟
قطعاً، الكثيرُ من السوريين يعتبرونه شوطاً في العبور إلى سوريا الجديدة، لكن الكثيرين أيضاً يرون فيه إثباتاً لرؤيتهم في أنّ نظاماً كالذي يحكم سوريا لا تزلزله صحوة شعبٍ هو أساساً غير واعٍ لما تعنيه ثورة وغير مستعد -كما أثبتت الوقائع- للخوض في غمار نظامٍ مؤسساتيٍّ قائم على أسس المواطنة والديمقراطيّة.
لا أبتغي من إثارة هذه النقاط أن أخلص إلى أنّ الشعب السوري لم يكن جاهز أو مستعد للتجربة الديمقراطيّة، فهذه حقيقة التمسها كلّ مراقب ومنذ فترة غير قريبة، إنّما أهدف إلى مناقشة الوضع الذي آلت إليه الإشكاليّة السوريّة.
على حافة البداية
سأبدأ من حيث يقف كل سوري وهو يقرأ هذه السطور، رغم أنني على يقين أن فكرة القراءة قد أنهكت معظم السوريّين، إلا أنني على نفس المستوى من اليقين أنّهم جميعاً توّاقون إلى إيجاد ما يمكن أن يغيّر المشهد حتى وإن كانوا جاهلين لما يمكن أن يكون.
سأبدأ إذن مما اقترف الجميع من أخطاء، لن أقول من جرائم لأنّهم ليسوا متساوين في مستوى المسؤولية، لكنهم قطعاً متساوين في مستوى تحمّلها.
لا بدّ أنّ الكثير من السوريين يتذكّرون الفترة التي سيطرت فيها عليهم شجاعة ألف ثورة للانخراط بكلّ ما يسكنهم من ألم ووجع في رفض منظومةٍ سلبتهم حريّة الرفض، لكنّهم الآن يقفون على قمّة اليقين من عدم الجدوى.
قاسية هي تلك المرحلة التي نشعر فيها أننا امتلكنا الحقيقة، وفي ذروة الاعتقاد نكتشف أنّنا كنّا في أعلى مستويات الخديعة! ربما رغبتنا الجامحة في التغيير والتمرّد تجعل عقلنا الباطن يُغشي تفكيرنا عن الواقعيّة وتُسدل عليه أحجبة من الأوهام التي تَسمك وتتراكم لدرجة يصبح فيها الضوء غوراً من السواد.
هي تلك اللحظة التي آمن فيها الكثير من السوريين أنّ المجتمع السوري يخضع لما يُسمّى قانون التطوّر الاجتماعي، وأنّه وبعد عقودٍ من السلطة المطلقة تتجمّع كل العوامل التي تفضي إلى التوق للانتقال إلى مرحلة أكثر انفتاحاً وتحرّراً وأقلّ استملاكاً. هذا ما دئبنا أن ننعته بالسياق (الطبيعي) للمجتمع (الطبيعي)، لا سيّما عندما نتحدّث بلغة النظريّات وتطوّر الحضارات، والتي تجعل من الفكر الثوري مرحلة حتميّة تتفتّق من خلالها تركيبة العقلية المجتمعيّة مفضية إلى عناصر جديدة تتجمّع لتبني المراحل المستقبلية للمجتمع.
في حالة المجتمع السوري لم يكن السّياق طبيعياّ، ليس فقط لأنّ المجتمع لم يكن طبيعيّاً، بل لأنّ النظريات تصبح عاجزة بالضرورة عندما تحاول أن تؤطّر المجتمع في سياق الطبيعي أو غيره. ولأنّنا عندما نفرض حق الوصاية والاستحواذ على صيرورة المجتمعات نفقد القدرة على فهم المتغيّرات خاصة النسبيّة منها والكامنة في عمق طبيعية المجتمعات التي ننسب لنظرياتنا القدرة على فهمها والتنبؤ بما يمكن أن تؤول إليه بخضوعها لعوامل متشابهة.
لقد أدّت بنا نظريّاتنا إلى إغفال عوامل العقل التاريخي، والتركيز على العقل الجمعي، لنكتشف ونحن في قمة جرينا وراء إثبات النظرية أنّ العقل المجتمعي في الحالة السوريّة يستهدف السلطة ذاتها ويتوق إلى إعادة إنتاج الظلم نفسه، بل وبمستوى أشد تطرّفاً وفوضويّة. ذلك أنّ سياق التطوّر التاريخي لهذا المجتمع لم يكن (طبيعياً)، بل يخضع للتغيّرات النسبيّة.
لقد تعرّض هذا المجتمع خلال ثلاثة عقود، وإن بدرجات متفاوتة، إلى مستويات عالية من التسلّط، بحيث تعايش معها بشكل سليم وسلمي، وتماهى مع درجات التسلط المطلق بطريقة متفرّدة. هذا المجتمع كرّس الاستبداد بشكل مشابه لتكريسه التحرّر وتماهى معهما وبهما فتشكل لديه حول المفهومين مقاربة خطيرة تخلص في النهاية إلى أنّه إذا توفّر في كلتا الحالتين نفس السويّة من عناصر الأمان فلا ضرورة لاستبدال أحدهما بالآخر. لا سيّما إن كان الأثر السلبي لا يمسّ إلّا الأفراد المتمرّدين (اللا منسجمين مع الحالة العامّة).
والتعايش في هذه المراحل أنتج عناصر سلبيّة أكثر قوّة، أثّرت على تماسك نظريّة التماثل في حالتي التحرر والتسلّط، أعني هنا تحوّل (تراجع) القيم. يجب علينا هنا ألّا نغفل أن المرحلة الأطول كانت التسلّط المطلق، وبالتالي كانت كافية لتتمدّد فيها عناصر تحوّل القيم وتصبح حالة سائدة وظاهرة (سليمة)، وهذه الحالة من التماهي بين القيم واللّا قيم أنتج لدى العقل الجمعي التاريخي حالة مجتمعيّة عامّة متماهية بين السلبي (الشر) والإيجابي (الخير).
تلعب هنا سياسة المتسلّط دور المحفّز من خلال المكافأة المجتمعيّة، فأنت عندما تكون متمايزاً (حتى ولو سلبياً) فأنت العنصر الأقوى، وبالتالي يصبح الهدف هو التمايز، وطالما أن حالة التماهي سائدة، إذن المجتمع يدفعك بل ويكافئك على تمايزك (السلبي)، كل ذلك في إطار تحوّل لا قيمي جديد.
هذه الجموع التي قد كرّست خلال عقود ودون توقّف منظومةً لا متناهية من التفاصيل المتراجعة حضارياً، بالضرورة ليست قادرة على إنتاج مستوى جديد من التطوّر، وهي وبالضرورة لديها أعظم إمكانية على هدم وشلّ القدرة على زرع بذور الارتقاء إلى مستويات جديدة. بالتالي عند فشل عمليّة التغيير تبدأ العناصر اللا قيميّة بالتمدّد لأكثر، هذه المرّة من أجل البقاء لا من أجل التمايز.
من هذا المنظور، فشلت فكرة احتضان شعب بهذه الشروط لفكرة الثورة أو حتى لقيم التغيير الإيجابي بأقل مستوياته، ومن المنظور نفسه استحالت فكرة إرساء قواعد بناء جديدة لمرحلة إيجابية. ولعلّ الأكثر دقة في هذا السياق هو القول أنّ اختراق شعب كهذا من خلال عظمة فكرة كالثورة كان أشبه بمحاولة السيطرة على سيل عارم بحفر قنوات بشكل بدائي ويدوياً. وبالنتيجة سيهدم السيل كل شيء، كما ستنهار جميع مشاريع محاولات البناء ومعها جهود القائمين عليها، ويتهاوى حلم التغيير.
الأسوأ في هذه الإشكاليّة أننا لا نعود إلى نقطة الصفر فحسب، إنما نتراجع عنها مراحل يصبح معها بلوغ هذه النقطة هو الهدف. بمعنى أنّنا كشفنا الغطاء، بقصد أو عن غيره، عن أسوأ ما في هذا المجتمع. وتبرز في هذا السياق إلى السطح الإشكاليّة الأعمق: هل هذا الشعب وصل إلى المستوى الذي (يستحق) فيه، ويدرك، التغيير التطوّري؟
أعلم أنّ هذا الطرح يؤلم الكثيرين، بنفس القدر الذي يجعلهم يستذكرون بمرارة فكرة الثورة في أضغاث أحلامهم، لكن لا بدّ لي قبل أن أتناول الأفكار التي أود طرحها في سلسلة المقالات القادمة من أن أبدأ من هذا الطرح لأنّ عدم المواجهة لا يمكن أن يعني انعدام الحقيقة.
ليفانت - منال محمود
العلامات
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!




















