-
خطاب الغاضبين
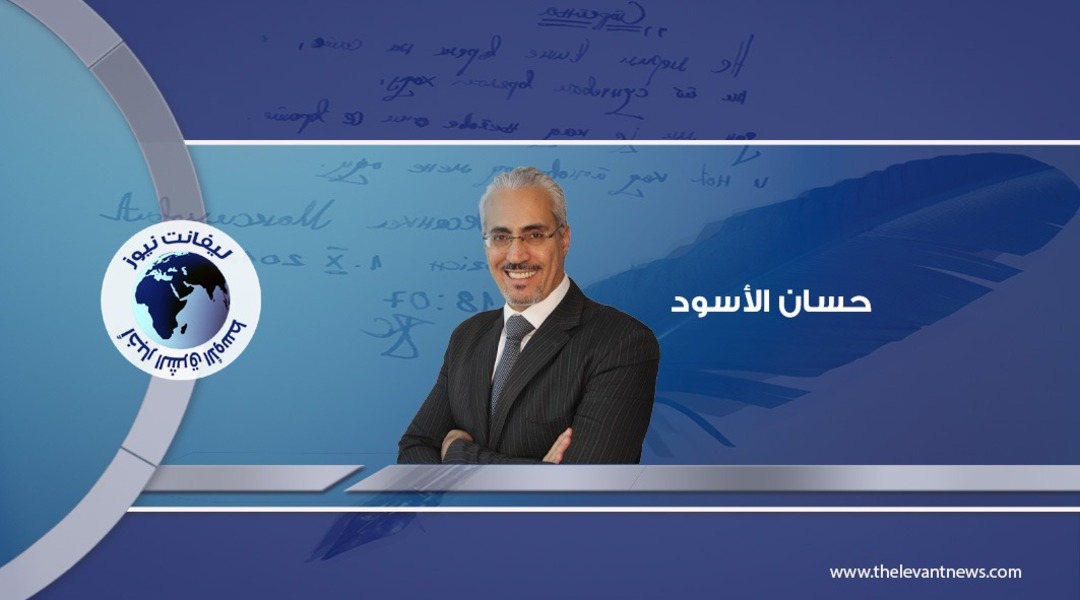
قلّما يشاهد المرء في الغرب سياسيين غاضين، وإن حصل ووجد بعض أولئك الذين يطرحون أفكارهم بحدّة وجلافة أحياناً، أي عندما يمارسون النقد اللاذع الذي لا يستثني شيئاً حتى أشخاص المتحاورين، فإنّ الأسلوب يختلف جذرياً بلا أدنى شك عمّا ألفناه في بلادنا العربية. ونتحدّث هنا بالطبع عن تلك البلدان التي يحظى الناس فيها بهامش من الحريّة مثل الأردن ولبنان وقطر والكويت، وعن تلك التي يحكمها الديكتاتوريون، ففي كلا النموذجين نرى نفس الغضب والغاضبين، وبالتالي نسمع صياحاً وصراخاً ولا نصادف حواراً ومتحاورين.
في الغرب ليس من المعتاد أن يرفع المتحاورون في البرامج التلفزيونية مثلاً أصواتهم تجاه بعضهم البعض، أو تجاه الجمهور، سواءٌ أكانوا سياسيين، أم نقابيين، أم مفكرين، أم فنانين، فما بالكم برفع أصابعهم وأيديهم أو الكراسي التي يجلسون عليها، كما حصل ونشاهد كثيراً في برامجنا الحوارية مثل الاتجاه المعاكس. كذلك يندرُ جداً أن يتلاسن البرلمانيون في هذه الدول، على عكس ما يحصل في بلداننا العربية التي طالما شهدنا في عدد منها استعمال القبضات لتوجيه اللكمات بين الزملاء تحت القبّة التي من المفترض أنها تجمعهم للتعبير عن إرادة ناخبيهم، أي الشعب الذي يمثلون.
طبيعة الأشياء ومنطق السياسة يفرضان ألا يكون الحوار بين غاضبين، فهؤلاء لا يمكن أن يصلوا إلى نتيجة من حوارهم، أو بالأحرى لا يمكن أن تُسمّى العلاقة التواصلية بينهم حواراً. فأوّل ما يتطلّبه الحوار هو الهدوء، لأنّ جوهره يعتمد على الإصغاء والتفكّر أكثر منه على الكلام. ثمّ لا بدّ من حواجز يضعها المتحاورون بين رغباتهم وأفكارهم، وهذا أمرٌ يحتاج إلى تنشئة مُسبقة وبيئة خاصّة، أي إلى تدرّبٍ على فهم جوهر الكلام لا مجرّد التقاط العثرات فيه لنقضه ودحضه. كذلك يجب أن يتوفّر المناخ العام الذي يجري فيه الحوار على ضمانات لعدم الشيطنة، فمن يأمن على نفسه من الإقصاء أو الإلغاء، يمكن أن يطرح أفكاراً تكسر المألوف، أمّا الراغب بالحصول على رضا جمهورٍ معيّن، فلا يُتصوّر أن يصدر عنه شيء ذو قيمة بعيداً عن مخاطبة الغرائز أو العواطف.
لا يهدف المتحاورون بحقّ عادة لإثبات صحّة وجهة نظرهم، بل لفحصها. أي إنّ العالم أو المفكّر أو الفيلسوف لا يجب أن يكون جازماً في رأيه حاسماً صحّة وجهة نظره، لأنّه ما من حقائق ثابتة على الإطلاق. صحيح أنّه يوجد دوماً وقائع، لكن هذا لا يتعارض مع مبدأ نسبيّة الحقيقة التي هي في تغيّر دائم. فحقيقة سطوع الشمس مثلاً، كانت قبل اكتشاف مركزيتها بالنسبة للأرض مُطلقة باعتبارها تدور حول الأرض لا العكس، وهذا انعكس بطبيعة الحال في اللغة، فنحن نقول شروق الشمس وغروبها، ولا نقول التفاف هذا القسم من الكرة الأرضية نحو الشمس وانحسار ذاك عنها. الأمرُ إذن خليطٌ بين ما نعتقده عن الوقائع والحقائق وبين الوقائع والحقائق ذاتها. وهنا يتداخلُ الذات بالموضوع حتى لا يكاد يستطيع المرء التمييز بينهما.
في أغلب مجتمعاتنا الشرق أوسطية، لم نتدرّب على مخاطبة عقولنا، فنحن رهائن لبيئة طاردة للفكر منتجة للعنف. وهذا العنف ليس بالضرورة محصوراً في سلوك السلطات الحاكمة، ولا بالعنف المجتمعي فقط، بل هو عنفٌ يشمل الثقافة والفضاء الذي نعيش به. تحت شعار مقاومة الاستعمار ودحر الإمبريالية وتحرير فلسطين ربِيَتْ أجيالٌ وأجيال، وتحت سياط إرهاب السلطات الديكتاتورية الحاكمة، والخوف من الاعتقال والتغييب والتعذيب نمت عقولنا ونفوسنا، وتحت ضغط العادات والتقاليد والأنماط الدينية المسيطرة تقولبت أفكارنا ومعتقداتنا وأحلامنا. فبات وجودنا مرهوناً بالعنف، وهذا يولّدُ الغضب كردّة فعلٍ عليه وعلى العجز عن مقاومته، فيصبح الفرد حلقة من سلسلة متكررة تمارس بدورها العنف ضمن محيط سيطرتها، سواء في الأسرة أو العمل أو المدرسة أو الحيّ أو حتى في مجالات وسائل التواصل الاجتماعي. نستذكر هنا على سبيل المثال الخطاب الذكوري القمعي الذي مارسه أحدُ البرلمانيين الأردنيين ضدّ زميلة له في البرلمان، فهو لم يعتد أن يسمع من السيدات إلا كلمات السمع والطاعة، فكان الغضبُ وكان العنفُ منه تجاهها، (اقعدي يا هند)، وكأنها جاريته!
قلّة من العاملين في الشأن العام مثلاً من يستطيعون التحكّم بمشاعرهم وردود أفعالهم، فترى الغالبية تنتفض عند أوّل إحساس باعتداء يمسها شخصياً، بينما لا تجد حوادث مماثلة تمسّ الشأن العام ذاته أيّ ردّ فعل. ولتوضيح الأمر نضرب مثلاً يمسّ جوهر الوجود والحياة للمسلمين والمسيحيين في فلسطين، فعمليات تهويد القدس وتهجير أهلها والاستيلاء على أملاكهم وتشريدهم والسيطرة على مقدّساتهم من خلال تكريس احتفالات اليهود في أماكن عبادتهم شيئاً فشيئاً، لم تجد أيّ ردود أفعال رسميّة ولا شعبية. بينما رأينا كيف تكون الهبّات الهادرة إن تعرّض حاقدٌ أو ملحدٌ أو مُستهزئ لاسم الرسول صلى الله عليه وسلّم! أليس في هذا قصورٌ واضحٌ عن فهم الأمور ومجرياتها؟ وهل الرسول (ص) بحاجة لهبّاتنا وغضبنا، وهو من كرّمه الله وأغناه عنّا، أم شعب فلسطين وشعب اليمن وشعب سوريا وشعب الأيغور في الصين أو الروهينغا في ميانمار بحاجة أكثر لها؟
لا شكّ بأنّنا لم نحظَ بالفرصة لتعلّم هذا كلّه، فمن يفتقد لأبسط متطلبات العيش الكريم مثلاً، لا يجد مساحة بين أولوياته لمجرّد التفكير بالشأن العام، فما بالنا بالحوار والنقاش للوصول إلى الحقائق. إنّها علاقة تكامل بين الجغرافيا والتاريخ والسياسة والحقوق والمجتمع، ونحن نتدرّب على الحوار من خلال التواصل فيما بيننا، وعندما كانت الساحات والشوارع مفتوحة أمامنا، استطعنا إنتاج خطابٍ عقلاني متوازن، لكننا انكفأنا على أعقابنا تحت ضغط القهر والاستبداد ثانية عندما واجهتنا جيوشنا بنيران المدافع والدبابات، فهل يُعقل أن يكون خطابنا مع هذا كلّه غير خطاب الغاضبين!

ليفانت - حسان الأسود
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!






















